⏪ المالينخوليا، هي السَّعادة في أن تكونَ حزينًا
فيكتور هيغو
1 - كيف يحتمل السُّوداويُّ مُكوثه في العالم؟
ثمَّة من النَّاس من اختار انتهاج السُّوداويَّة رؤيةً للعالم ومقاربةً من مقارباته المتعدِّدة ومسلكًا جماليًا يعبُر تفاصيل الحياة وأفانينها،
والمالينخولي في الأصل إنسانٌ يائسٌ من العالم ومن النَّاس، ليس يأسهُ يأسًا رومنسيًا ساذجًا أو حالة انفعاليَّة عابرة، بقدر ما هو كينونةٌ تُنحتُ وتُؤَصَّلُ طيلة مكوثه في العالم.
تعرَّض ابن سينا في كتابه القانون في الطبِّ إلى المالينخوليا باعتبارها حالةً مَرضيَّةً مُحدِّدًا أعراضها قائلًا:
علامة ابتداء المالينخوليا ظنٌّ رديء، وخوفٌ بلا سبب، وسرعةُ غضبٍ، وحبُّ التخلي واختلاجٌ، ودوارٌ ودوىٌّ وخصوصًا في المراق. فإذا استحكم، فالتفزغُ وسوءُ الظنِّ، والغمُّ، والوحشةُ، والكَرب، وهذيانُ كلام، وأصنافٌ من الخوف مما لا يكون أو يكون.
وإذا كان تعامل ابن سينا وسائر النفسانيين مع المالينخوليا تعاملًا طبيًا اكلينيكيًا فإنَّنا نُقاربها خارج الفضاء الصحِّي، لذلك نختلف معهم في الرُّؤية العامَّة للحالة السُّوداويَّة-التَّشاؤميَّة-المالينخوليَّة من حيث اتِّفاقنا في تشخيص الأعراض.
حسم المالينخولي أمره مع مفردات من نوع: قصد، غاية، هدف، معنى، مطلق… ولم يعد يهمُّه ماذا يقع في الضفَّة الأخرى من العالم، ولا ما وقع في غياهب الماقبل، ولا ما سيقع في سرمد الماوراء.
كيف للإنسان أن يحتمل مكوثه في هذا العالم، لولا تلك الأضرب من الوهم الجميل (الفنُّ، المُثل العليَا، شرائع الخلاص المزعوم…)، عدا ذلكَ فإنَّ الحقيقة لا تُؤدِّي إلا إلى ثلاثة طُرق: اللَّامبالاة المطلقة (وهي درجة عُليا من الحصافة) أو الجُنون (وهو عينُ الوعي بالعالم) أو الانتحار…
ينتمي المالينخولي إلى سجلِّ اللامبالاة المطلقة، حيث الانتماء إلى اللاانتماء، وليس ثمَّة ما يدفعه إلى الانتحار، لأنَّ الانتحار عادةً ما يكون نتيجة خيبةٍ متأخِّرة. يقول إيميل سيوران في شذرة خاطفة:
لا ينتحر إلا المتفائلون، المتفائلون الذين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في التفاؤل. أما الآخرين فلماذا يكون لهم مبرر للموت وهم لا يملكون مبررًا للحياة.
المالينخولي كائنٌ سعيدٌ من شدَّة الحزنِ لأنَّ الحزنَ مصْلٌ مضادٌّ لنفسهِ، لا خشيةَ من شيءٍ إذنْ ولا أمل في شيءٍ، لا انتظارات ولا خيبات. يكفي الالتذاذ بما هو متاحٌ، لأنَّ اللِّذَّة مصدر كلِّ خير وفق المعلِّم “أبيقور”، والخيرُ كلُّ الخير في تجنُّب كلِّ ما يسبِّب الألم. تُعدُّ الإيتيقا الأبيقوريَّة وصفةً مثاليَّة لحياة المالينخولي السَّعيد: الالتذاذ في حدود المتاح، تجنُّب كلِّ ما يشكِّل مصدرًا للآلام، عدم الخشية من الموت ولا من القوَّة المفارقة، القدرة على تنسيب الألم والمصالحة معه.
يحاول المالينخولي الفكاك من كلِّ الارتباطات المحدَّدة بصفة قبليَّة، إذْ لا معنى للوطن فهو من قبيل المصادفة الجغرافيَّة، ولا معنى للعائلة لأنَّها مُؤسَّسةٌ على حتميَّات بيولوجيَّة، ولا معنى للعلاقات المبنيَّة على الانفعالات الطَّارئة والعرضيَّة. لذلك فإنَّه جازمٌ حازمٌ في مقاطعته لفكرة الزواج والتَّناسل؛ ففي زيادة النسل زيادةٌ في عدد الأشقياء. جاء في مصنَّف الدّراري في ذكر الذّراري لابن العديم الحلبي أنَّ فيلسوفًا سُئل: لم لا تطلب الولد؟ فقال: من محبَّتي للولد. وقيل لآخر: لو تزوَّجت فكان لك ولدٌ تُذكر به، فقال: والله ما رضيت الدنيا لنفسي فأرضاها لغيري.
لا يذهبنَّ في الظنِّ أنَّ المالينخولي السَّعيد داعية كراهيَّة أو صاحب نزعة تصفويَّة إباديَّة، فهو يفقد القدرة على الحبِّ والكره تدريجيًا خلال حياته القصيرة، لا شيء يستحقُّ الكره، كذلك بالنسبة إلى الحبِّ، كلُّ الموجودات سواسيَّة لأنَّها باطلةٌ بالأصالة وقبضٌ للرِّيح. الحياة عديمة الجدوى، وإذا وضعنا لها هدفًا على سبيل التجوُّز فإنَّه حتمًا سيكون الموت، لم يعد الموت مصدر خوف، بل هو صديق طيِّب للمالينخولي السَّعيد، وطيبته تكمن في حكمته المُعرِّيَّة للحياة.
يسخر المالينخولي من النَّوع الإنساني، بل ويشعر بالعار إذا تذكَّر انتماءه إلى هذا النَّوع، لذلك فهو محكومٌ في تمثِّله للعالم بـ”إرادة الفناء”، وتنزع هذه الإرادة إلى الإنهاء الوجودي للنوع الإنساني بعامة، حتَّى يعود النَّظام الطبيعي إلى مجراه، فالإنسان كائنٌ ناشزٌ، وقد تسبَّبَ نشوزه في إفساد العالم رغم التقدُّم الحضاري الظاهر. يقول جان جاك روسو في مقالته الرَّائدة في العلوم والفنون:
… وأنفسنا ازدادت فسادًا بقدر ما ازدادت علومنا وفنوننا كمالاً. أن يقول بعضهم إنَّها نكبة خاصَّة بعصرنا؟ كلَّا، يا سادتي، فالشُّرور الناجمة عن فضولنا الباطل إنَّما هي قديمة قدم العالم…
هل في نفس المالينخولي السَّعيد رغبةٌ في إصلاح ما قد فسدَ؟ كلا، إنَّ الضَّررَ هائلٌ وجبره صار محجوبًا عن الأفق. المالينخولي عدمي في المستوى الإيتيقي العام وفي مستوى السِّياسة. كلُّ تدبير للشَّأن العام هو تدبيرٌ للألم، وكلُّ سلطة تبدع مسخها الفرانكشتايني من حيث تدري ومن حيث لا تدري، فالأنظمة المجرمة كما يقول ميلان كونديرا:
لم ينشئها أناس مجرمون، وإنَّما أناس متحمِّسون ومقتنعون بأنَّهم وجدوا الطريق الوحيد الذي يُؤدِّي إلى الجنَّة.
قد يبدو المالينخولي السَّعيد متناقضًا في كثير من مزاعمه، فهو سعيدٌ من حيث حزنه، وموجودٌ من حيث إرادته للفناء، وعلاقاته الإنسانيَّة والعائليَّة طيِّبةٌ من حيث عدم إيمانه بأيِّ ضرب من الارتباطات! لكن التناقض الظَّاهر بالنسبة إليه ليس “نقصًا، أو خطأ، أو ضعفًا. إنه حركة حياة وكينونة. ورؤية عقلية متجددة” على عبارة عبد الله القصيمي، إنَّه حالة من القلق الدَّائم والارتياب اللَّامتناهي.
في ختام هذا المانيفستو، يريد المالينخولي السَّعيد بيان أنَّ لامبالاته غير ناجمة عن طيش أو فراغ وإنما هي حصافةٌ ورؤية للعالم واكتناه مباشر للألم الإنساني، فلا عزاء لهذا الألم إلا في فكرة فناء الإنسان ذاته باعتباره كائنًا مسيئًا إلى نفسه فضلاً عن إساءته إلى بقيَّة الموجودات.
صدق محمود درويش – وهو أحد الكائنات المالينخوليَّة السَّعيدة – إذ قال في سطرٍ شعري جميل جليل:
في اللَّامبالاة فلسفةٌ، إنَّها صفة من صفات الأمل.
2 - الوُجُودُ لَعِباً: تأمّلاتُ كائنٍ عابثٍ
مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ – الدّهريون العرب
بعدَ أن أضنتهُ التّجربة الوجوديّة وصار العبثُ بالنسبة إليه مذهبًا راسخًا، ارتأى المالينخولي السّعيد أن يضطلعَ بتدوين تأمّلات تكون بمثابة تأصيلٍ لكيانه. و قد تخيّر الكتابة على نحوٍ شذري/مقطعي بما يتلاءم مع مزاعمه و مصادراته، دون أن يتورّط في التشقيق المنطقي أو البناء النّسقي، فخارطته الوجوديّة تتشظّى و تتشقّق في انتظار السّقوط الأخير، و كذا نصّهُ.
ورد في لسان العرب أنّه يقال لكل من عَمِلَ عملاً لا يُجْدي عليه نَفْعاً: إِنما أَنتَ لاعِبٌ. يكُونُ الإله بناءً على هذا المعنى اللّغوي لجذر ( ل.ع.ب) أوّل كائنٍ لاعبٍ، باعتباره مُنشِئًا لوجودٍ لا يجدي عليه نفعًا و لا ضرًّا. تفطّن “أبيقور” إلى هذه اللّطيفة حينما أقرّ بأنّ الآلهة كائنات كاملة و مغتبطة و منزّهة عن كلّ ما عداها و مكتفيّة بذاتها ! و إذَا كانت حقًا كذلك، تكونُ آلهة لاعبة/عابثة بإيجادها للموجودات. لكن إذا أردنَا قَلْب المعادلة، و جعلْنَا المخْلوقَ مكانَ الخالقِ، لانْفكَّ اللُّغز و تنزّه الإله عن نقيصة اللّعب : لقدْ اخترعَ الإنسانُ الآلهة لحاجةٍ في نفسهِ، و بذلك ارتكب أوّلَ حماقةٍ فاصلةٍ في تاريخه : حماقةُ المعْنى/الغاية.
إذا كانَ العبثُ نقيصةً بالنسبة إلى الإله، فهو شرفُ الإنسانُ و أعلى تجلّيات وعيِه بذاته/حجمه/منزلته. لقد كانت فتوحات مُبينة تلك الكشوفات المعرفيّة التي خلخلت مسلّمات النوع الإنساني و قضقضت نرجسيّته كوسمولوجيًا و بيولوجيًا و سيكولوجيًا… لقد انبجست من تلك الثورات سرديّةُ الارتياب. و شرع الإنسانُ في إزالة السّحر/الوهم عن نفسه و عن العالم. لكنّهُ أعاد بناء أوهامه في سياقات علمويّة/وضعانيّة/حداثويّة أفضت به إلى الكارثة. و ماذا بعدَ الكارثة ؟ إنّها تباشيرُ فجرٍ جديد !… لقد عمّ الاستياء و الضّجر و الامتعاض و تفشّى اليأس و انتشرت اللّامبالاة و صارت الأرض حوضًا من حياض الجحيم يتقيّأ فيه غريبُ الأزمنة الحديثة… لقدْ وُلِدَ “اللّامنتمي” رسميًا !
وُلد اللّامنتمي بصفة رسميّة إبّان النّصف الأوّل من القرن العشرين، أي إبّان الكوارث الكونيّة المقنّنة و المُوَقّعة. و افتتح بولادته عصر العبث غير الخجول/ العبث الصّارخ، عصر إسدال السّتار عن كلّ التوهّمات الإنسانيّة، عصر تكشّف القُبح سافرًا مُتبرّجًا دون رياء. إنّ اللّامنتمي عينه الإنسان الأخير، دشّن بولادته بداية النّهاية، إنّهُ صوتٌ صارخٌ في البريّة الإنسانيّة، حيثُ الوحشةُ و اصطكاك الأسنان. إنّ عصر اللّامنتمي عينه عصر تجلّي الرّوح الكلّي الحقيقي و انكشافه – لقد خسر هيغل الرّهان -، عصر ظهور الذئب نازعًا عنه ثياب الحمل الطّيب الأخلاقي، لا مطمع بعد في أساطير الخلاص والمخلّصين، ولا إيمان بعد في غائيّة التّاريخ و نبل مقصده، و لا اعتقاد بعد في العناية الإلهيّة.
يقوم الإدراك الإنساني على الفنطاسيا أو التّوهّم، فهو تمثّلي في كنهه. و بالعودة إلى مصنّف شوبنهاور “العالم إرادةً و تمثّلًا” – يُعتبر من روافد المالينخولي السّعيد الكلاسيكيّة – ، نعثر على هذه الفكرة بوضوح : فالإنسان“لا يعرف شمسًا و لا أرضًا، و إنّما يعرف فقط عينًا ترى شمسًا و يدًا تحسّ أرضًا، و أنّ العالم الذي يحيط به إنّما يكون قائمًا هناك بوصفه تمثّلًا فحسب”. تنتفي وفق هذا التقرير أسطورة تطابق المقول بالمعقول بالمحسوس. فالإنسانُ كائنٌ واهمٌ بالضّرورة، لا يرى إلّا ما تسمح له حواسه الخادعة برؤيته و لا يتمثّل إلّا ما يمليه عليه ذهنه المحكوم بإكراهات البيولوجيا ( قد يتسبّب الفصام مثلا -و هو مرض عضوي يصيب الدّماغ – في هلاوس سمعيّة لا وجود لها في العالم الحقيقي ) . يكون التّمثّل إذنْ لعبةً موغلة في الفردانيّة، شكل من العبث بالوجود و تشكيله و قولبته كالطّين الأملس.
يقول المالينخولي السّعيد في إحدى يوميات خيبته : “ماذا أفعل في هذا العالمِ ؟
أستيقظ كلّ يوم على وقع هذا السّؤال المُربكِ. تُعاوِدُني الرّهانات الكانطيّة بخصوص المنزلة و الواجب و الرّجاء و المعرفة.
ماذا يمكنني أن أعرف ؟
يكفي أنّي عرفتُ الخيبةَ تتكرّرُ في التّاريخ و في أنحاء الرّوح.
ماذا يجب عليَّ أن أفعلَ ؟
أنا سليل المنهزمين النّاعقين المبشّرين بخراب العالمِ و بطلانه. من سليمان الحكيم مرورًا بالمعرّي وصولًا إلى إيميل سيوران، أنا تلك البومة الوديعةُ، نذيرُ الشُّؤمٍ علامةُ الحكمةِ.
ما الذي يجوز لي أن آمل ؟
كلُّ تقنيات الرّجاء استنفذت إمكاناتها، أكتفي بترديد تلك الحكمة البوذيّة المحفورة على شاهد قبر نيكوس كازانتازاكيس، ”لا آمُل في شيء، لا أخشى شيئًا، أنا حرٌّ “. ما الإنسان ؟ الإنسانُ كائنٌ مسخٌ، يبدعُ أصفادًا إذا أطلّ الصبحُ ثمّ يحاول الفكاك منها سرًّا إذا وقبَ الغاسقُ، يبذلُ الجهد الجهيد موسمَ الحصاد ثمّ يحرقُ السّنابل ليشرعَ في الحربِ على الفُتاتِ، ضبعٌ يقتات على جيفة بني جنسهِ، ذئبٌ لأخيه، حفّارٌ للقبور الباذخة، طمِعٌ في حياةٍ فوقَ الحياةِ، حقودٌ حسودٌ ميّالٌ إلى الشرِّ نزّاعٌ إلى الأذيّة…
تلكَ طريقتي في تَصْريفِ النّكدِ اليوميِّ، و كلُّ ما أبوحُ بهِ تنويعٌ على هذا القولِ الجللِ : باطِلُ الأَبَاطِيلِ،الْكُلُّ بَاطِلٌ وَقَبْضُ الرِّيحِ. ( سليمان الحكيم – سفر الجامعة )”
3 - رجل لا يدري ويدري أنَّه لا يدري
“وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” – قرآن كريم ( سورة الأنبياء )
“لَيْتَ كَرْبِي وُزِنَ، وَمَصِيبَتِي رُفِعَتْ فِي الْمَوَازِينِ جَمِيعَهَا، لأَنَّهَا الآنَ أَثْقَلُ مِنْ رَمْلِ الْبَحْرِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ لَغَا كَلاَمِي.” – الكتاب المقدّس (سفر أيّوب )
لماذا تحدث أشياء ضارة ؟ قال المالينخولي السّعيد و قد استبدّ به الحزنُ، كأنّه يحمل ثقل العالم وآلامه. لماذا يتألّم الإنسان؟ لماذا يقع فريسةً لتقلّبات الحياة؟… هكذا انسابت الأسئلة في ذهن صاحبنا و تبدّت له في شكل معضلات تعصى على الاستيعاب. ثمّ استعاد معضلة الشرّ التي أثارها أبيقور وارتفعت من بعده إلى مقولة دهريّة غالبًا ما يضمّنها الهراطقة والزنادقة في سجالاتهم ضدّ حرّاس العقائد وزبانية القداسة، إذ كيف يحدث الشرّ في العالم تحت عناية ربٍّ رحيمٍ؟ لماذا يصابُ الرُّضّعُ بالأدواء المزمنة؟ لماذا تنزل الكوارثُ بالبشر فتخبطهم خبط عشواء؟ لماذا لا تتكافأ الفُرص في الأعمار و الأرزاق…؟
يمكننا أن نزعم أنّ معضلة الشرّ هي الحجّة الأخلاقيّة الأقوى التي تدحض عقيدة العناية الإلهية، ورغم كلّ الرّدود الثيولوجيّة الغارقة في التبرير الفلسفي لمشكلة الشرّ ( الثيوديسيا ) إلّا أنَّها لا تصمد أمام تألّم صبيّ واحدٍ مصابٍ بداء عضال، ويمكن لكلّ اللّاهوتيات الدّفاعيّة ( الأبولوجيا ) أن تتهاوى أمام دمعة أمّ منكوبةٍ. لذلك أمكن لنا أن نخلص إلى مسلّمة مفادها أنّ العالم مُهملٌ ضدًّا على مبدأ العناية، وأنّ الطّبيعة قوّة عمياء لا تساير الإنسان ولا تخضع لمعاييره الأخلاقيّة، وأنّ حياة الإنسان محكومة بالصّدفة. إنَّ الحياة لعبة نرد، وما ثنائيّة الخير والشرّ ويا ينجرّ عنها من مفاهيم كالعدالة والقضاء والقدر والثواب والعقاب والابتلاء إلّا عزاءٌ ابتدعه الإنسان كي يبرّر بقاءه.
وُلدت ثنائيّة الخير والشرّ بسبب الاعتقاد في ما أسماه نيتشة “وهم العوالم الخلفيّة”، أي الاعتقاد في وجود كينونة متعاليّة خفيّة عن عالم الظواهر، و بناءً عليه فإنّ لكلّ حدث يقع في عالم الظواهر سببًا خفيًّا ينجرُّ رأسًا عن العوالم الخلفيّة ولا يكون إلّا تجلّيًا من تجليات القوّة الخفيّة وعيّنة ظاهرة من حقيقتها. مثلا : حين يضرب زلزالٌ منطقة ما، سيُفسّر الأمر بأنّه عقابٌ من القوى الإلهيّة لأهل تلك المنطقة بسبب خطيئة اقترفوها أو اقترفها بعضهم أو سيفسّرُ بأنّه ابتلاءٌ لاختبار إيمانهم وصمودهم أمام قدر الآلهة و قضائها. وبالتّالي تُضفى على الزلزال صبغة أخلاقيّة باعتباره تحقيقًا لعدالة الآلهة بين البشر في حين أنّه لا يتعدّى أن يكون حدثًا طبيعيًا تحكمه قوانين وسلسلة من الأسباب. إنّ قانون السّببيّة لا يعرف خيرًا ولا شرًّا، ولا يهمّه أنّ يحقّق عدلًا في عالم الإنسان، ولا يدلّ على إرادة فوقيّة، بل إنّه لا يدلّ إلّا على نفسه.
الإنسانٌ مُلقى على قارعة الكون، مُهملٌ ومتروكٌ للعدم، ليس ثمّة من يهتمّ لأمره غيره، ينبغي أن نتقبّل هذه الحقيقة كي نستطيع الصّمود أمام ما يحدق بنا من كوارث و آلام. علينا أن نستوعب أنّنا موجودون هكذا من دون مبرّر، نستمرّ في الحياة بسبب ضعفنا، و نموت عن طريق المصادفة وفق العبارة السّارتريّة. إنّ حياتنا مشرّعة على كمّ هائل من الممكنات المحكومة بثنائيّة المصادفة والسّببيّة. ولشرح ذلك يمكننا أن نضرب المثال التّالي : أن يكون زيد موجودًا في المنطقة ( أ ) وفي السّاعة ( ب )، وقد تزامن ذلك مع وقوع زلزال في السّاعة نفسها و المنطقة نفسها، وكان زيد من ضحايا ذلك الزلزال و لقي حتفه. في سيناريو آخر كان من الممكن أن يلزم زيد بيته ذلك اليوم وبالتّالي كان يمكن أن يسلم من الزّلزال، لكن تزامن وجوده في المنطقة ذاتها و الساعة ذاتها أدّى إل هلاكه. لذلك قلنا أنّ الممكنات محكومة بثنائيّة المصادفة ( تزامن وجود زيد وحدوث الزلزال في المكان نفسه ) والسّببيّة ( الزلازل تحدث نتيجة الإزاحات في الصّفائح التكتونيّة ). في ذلك اليوم الذي هلك فيه زيد بسبب الزّلزال بكت أمّ زيد وانتحبت مخمّنةُ أنّ موت ابنها كان بسبب قوى شرّيرة استهدفته، وخمّن بعض معارف زيد أنّ موته بتلك الطّريقة كان انتقامًا من الله بسبب بعض خطاياه.
استوعب المالينخولي السّعيد أنّ ما نسمّيه شرًّا، لا معنى له في عالم الظّواهر، وأنّ كلّ ما يحدث للإنسان من أمراض و أوبئة ومجاعات وكوارث طبيعيّة لا يمكن أن ندينها أخلاقيًا لأنّها لا تسير وفق إرادة معيّنة، ولا تستهدف أفرادًا أو مجموعات بشريّة وفق خطّة معيّنة، فكلّ ما يحدث يحدث من دون غائيّة أو ماهيّة أخلاقيّة مُحدّدة سلفًا. وعلى الإنسان أن يحاول الحدّ من الأضرار والتخلّص من أكبر قدر ممكن من الألم في خضمّ المصادفات والكمّ الهائل من الممكنات. وعلينا دائمًا أن نضع تلك الوصفة الأبيقوريّة نصب أعيننا : القدرة على تنسيب تجربة الألم ومسايرته والمصالحة معه… ويبقى العزاء الأخير للإنسان في كون الحياة فانية عاجلًا أو آجلًا.
4 - اعتزالُ الفِتَنٍ
“تُحدّثُونني عن أنباءِ السّياسةِ. لو عرفتُم كمْ أنا غير عابئٍ بها! لم ألمسْ صحيفةً مُنذُ أكثر من سنتين. كلّ هذه السجالات تبدو لي الآن متعذّرة على الفهم …” – آرثر رامبو
“أيّها المالينخولي السّعيد، توقّف عن حيادكَ الجبان، وجِدْ لكَ موقفًا من هذه الحرب القائمة بين قوى الظّلام وقوى النّور في عالمنَا، إنَّ عالمنا هو الأفضل بين العوالم الممكنة، وليس بالإمكان ما هو أبدع منه، فدعْ عنكَ جُبنكَ وسلبيّتكَ وخُضْ الحرب إلى جانب الحقِّ، إلى جانبنا نحنُ، وإلّا فإنّكَ محسوبٌ على أعداء الحقّ، أعدائنَا …”
كثيرًا ما يسمع المالينخولي السّعيد مثل هذه الخطب الوعظيّة من أصحابه ومعارفه، محاولين استدراجه إلى اتّخاذ موقفٍ سياسويّ مباشرٍ أمام ما يحدث في العالم من أهوال، مُوهمين إيّاه أنّ الحقَّ في قبضة طرفٍ بعينه، وأنَّ الشرّ من اختصاص عدوّ ذلك الطّرف، وأنّ الحرب بينهما حربٌ بين حقّ و باطلٍ، وإذا لم تخترْ الحقَّ فإنّكَ حتْمًا من أهل الباطل.
هكذا يتمُّ تصنيفُكَ والانتهاء منكَ بوضعك في أحد رفوف البؤس الإيديولوجيّ، فصمتُكَ يثير رعدتهم، إنّهم يهابُونَ غموضكَ وفرادتكَ ولا تقرّ لهم عينٌ إلّا بعد التَّأكّد من موقعكَ: إمّا معهم أو ضدّهمْ. لا يمكنكَ أن تقطُنَ خارج منطقتهم المانويّة، ومنطقهِمْ الثَّنائي القائم على تقسيم العالم تقسيمًا بدائيًّا لم يتجاوز ثنائيّات نحنُ وهُم والخير والشرّ والنّور والظَّلام والرَّحمن و الشَّيطان …
إنّ كمّاشة “الإحراج الُّثنائي الزّائف” آلةٌ ذهنيّةٌ صدئة، بها يحاولونَ اقتلاع المالينخولي السّعيد من الموقعْ الَّذي تخيّرهُ لنفسه حتّى يتسنّى لهمْ رؤيته بوضوحٍ، فإذا كانَ ضدّهم يُحاربونَهُ، وإذا كان معهُم يجنّدونهُ كي يُحارب إلى جانبهم، لكنَهم لا ينالون مُرادهُم لأنّهُ عصيٌّ على التَّصنيف، إنّهُ كائنٌ مُوغلٌ في فردانيّته ولا يستطيع أن يكونَ حطبًا في محرقةٍ لا تعنيه، ولا جنديًا في حربٍ يُعلِنُها الأباطرة ويُسحقُّ فيها سِفلةُ النّاس ومُغرَّرُوهم.
يُشدّدُ المالينخوليُّ السَّعيد على فردانيّته، فهي تُعدُّ من فضائله الَّتي يسلُكُ حياتَهُ وفقهَا، فصاحِبُنا منهمٌّ بذاته مُنشغلٌ بها، لا يطلب غير ملذّاته وسكينته، ذلك أنَّ حياته قصيرةٌ ولا تتّسعُ لأنْ يُهدرها في النّضال من أجل قيمٍ ومُثلٍ مُحالٌ إشاعتُها في عالمٍ تغلبُ عليهِ نزعاتُ العُنف والجشعِ، كيف يُمكنُ الاصطفاف خلفَ قائدٍ، أو زعيمٍ، أو سياسيٍّ يتبنّى مقولات مثل الأمّة والقوميّة والهويّة والدّين وصناعة المجد ويُتاجر بها في سوق المُثل العُليا والقيم الخالدة؟ لقد اُستغلّت هذه المقولات طيلة تاريخ النّوع الإنسانيّ من طرف أصحاب السّلطتين الزّمانيّة والرّوحيّة، وكُتبتْ الملاحم والأمجادُ بدماء الجماعات الَّتي وهبت نفسها فداءً لانتماءاتها، لكنَّ المالينخولي السّعيد يأبى أن يكونَ بيدقًا يخدمُ لحساب الشّاه على حسابِ سعادتهِ الفرديّة.
لن ينتهي بُؤسُ الإنسانِ إلّا بانقضاء نوعه، ولنْ تخمُدَ نارُ المحرقة دون التَّوقّف عن إيقادها، ولنْ تنتهي “الفِتَنُ” إلّا باعتزالها، هذا ما استقرّ عندهُ رأيُ صاحبنا، لمْ يتراجع المالينخولي السّعيد عن مواقفه الَّتي سجّلها في مناسبات سابقةٍ: مُعاداةُ التّناسل واليأس من الإنسان وإرادة الفناء والاستقالة من الحياة العامّة واعتزال القضايا الكُبرى والتَّمسّك بملذّاته الفرديّة البسيطة، تلكَ هي فضائله الَّتي يُصرّفُ من خلالها حياتهُ العرضيّة.
5- مانيفستو الموت السّعيد
“و الموتُ ليس برديءٍ. إنّما خوفُ الموتِ رديء” – الكِنْدي
“… غلِطت الأنفسُ-الضعيفة التمييز المائلة إلى الحسّ- في الموتِ، وظنّتهُ مكروهًا، وهو ليس بمكروهٍ” – الكِنْدي
الموتُ، ذلك العدوّ البغيض للنوع الإنسانيّ، هادمُ اللذّات الأشدّ إبهامًا بالنسبة إلى المعرفة البشريّة، يُثير رعدة الحاضرين أينما ذُكرَ إسمه، و يفزع له النّاس لمجرّد التفكير فيه أو تخيّله ، حُبّرت في ذكره الأسفار المقدّسة وحيكت من أجل فكّ سرّه حكاياتُ الأصلِ و مواعظُ المعاشِ و أساطيرُ المعادِ، و للموت أيضًا طقوسه و شعائرهُ التي لا تخلو منها ثقافةٌ مهما كانتْ “بدائيّةً” وفق تصنيف البعض. لكن ما الذّي يمكنُ للإنسان أن يجزمَ بمعرفته ؟ الإجابةُ محلّ اتّفاق بين أهل الإيمان وأهل العلم: “قُلْ إنّ الموتَ الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم”، و الموتُ أيضًا واقعة بيولوجيّة لا ريب فيها.
ماذا يعني أن نقرنَ السّعادة بالموت؟ و كيف يكونُ الموتُ سعيدًا؟ و هل بإمكاننا كتابةُ بيانٍ في مديح الموتِ؟ قد يبدو من غير الشائع أن نتحدّث عن الموت مقرونًا بالسّعادة إلّا في حالة الحديث عن السّعادة الأبديّة ، لكنَّنا نعلم أنّ المالينخولي السّعيد يقطعُ مع كلّ مفهوم أخرويٍّ، و أنَّ تأمّلاته و أفكارهُ منشدّة إلى ال”هُنا” لصيقةٌ با”لآن”. إنّ الأمرَ راجعٌ إلى نظرته إلى حياته، فهو ليس متعلّقًا بها ، بل هو رافضٌ لها بالأصالة و مستوعبٌ لعرضيّتها و مُرحّبٌ بحتميّة فنائها، لذلكَ فإنَّ صاحبنا لا يهابُ الموتَ بل يُصادِقُهُ و يُصالِحُهُ.
يُعرّف الفيلسوف الكِنْدي الحُزنَ بأنّهُ ” ألمٌ نفسانيٌّ يعرضُ لفقْدِ المحبُوباتِ و فوْتِ المطلوبَاتِ “، و الحياةُ بالنسبة إلى صاحبنا ليست بمحبوبةٍ و لا هي بمطْلوبةٍ، بل هي حُفرةٌ فارغةٌ و باردةٌ قُذفَ إليها قسرًا، لذلكَ فإنّ واقعة الموتِ واقعةٌ سعيدةٌ لأنّها خلاصٌ من هذا الوجودِ القسريِّ. تشكّلُ حادثة الولادة بداية مأساة الكائنِ المالينخوليِّ، أمّا الموتُ فإنّهُ أكثر النهايات الممكنة سعادةً لتلك المأساة. لقد أحسنَ الحكيمُ إيميل سيورانْ نقلَ هذه الفكرة حينَ قال:” نحنُ لا نركضُ نحو الموت، نحنُ نفرّ من كارثة الولادة”.
يُعدُّ الخوفُ من الموتِ حائلًا دونَ المُصالحة معهُ، هذا ما نتعلّمُهُ من الدّرس الأبيقوريّ، فالمعلّم أبيقور لا يرى في الموت ما يستدعي الخوف أو القلق، لأنّ الموت يقع في منطقة “اللّاوجود”، و تلك المنطقة لا تعنينا لأنّنا لا نقع في نطاقها، إنّ الموت “لا شيء بالنسبة إلينا ، إذْ عندما نكونُ فالموتُ لا يكونُ” لأنّهُ بمثابة فقدانٍ كلّي للإحساس، تلك هي خلاصة الدّرس الأبيقوريّ . لذلك ينبغي أن نتقبّل فكرة فنائنا في طُمأنينة ، فالموت يعني انعتاقنا من آلام الجسد و من مخاوف الفكر و من تقلّبات الحظّ.
لقد بات الموتُ موضوع تهكّم المالينخولي السّعيد بدلًا من أن يكون مصدر مخاوفه، فحدثُ الموتِ هو غايةُ العبث و مآلُ كلّ تعب الإنسان. يكفي أن تقف متأمّلًا أمام إحدى المقابر حتّى يتبيّن لكَ انعدام الجدوى، كلُّ قيمةٍ هي معدومةٌ أمام الموتِ. ليست هذه دعوة زهديّة و لا وعظة أخلاقيّة، إنّما هي لحظةٌ تُسفَّهُ فيها كلّ الأحزان المتعلّقة بالحياة اليوميّة و تفاصيلها السّمجة. إنّ لحظةَ المصالحة مع الموت هي لحظة تحرّر الإنسان من جميع مخاوفه وآماله.
ليس الموت بالحادثة الجليلة ولا هو بالواقعة المهيبة، لقد بات جديرًا بالكائن الإنسانيّ أن ينقُشَ على شاهدة قبره الكبير -تلك الحفرة الباردة ، أُمُّنا الأرض- تقريرًا عن تفاهة الموت و برودته. فأنْ ننتهي في فراشٍ تُرابيٍّ رطبٍ حيثُ نتحلّلُ بفعل البكتيريا ونهم الدّيدان، لا تزيد هذه النهاية التّراجيديّة عن كونها عمليّة بيولوجيّة صغيرة منخرطة في نظام اشتغال آلة الطّبيعة العمياء. تتبدّى “تفاهة الموت” جليّةً للناظر إذا ما فُكَّ عنهُ ذلك السّحر و نُزِعتْ عنهُ أهوامُ العوالِم الخلفيّة وأساطير الحيواتِ البَعْديّة.
حياةٌ ثُمّ موتٌ ثمّ… لاشيء! ما أشدّ غبطة المالينخوليّ السّعيد بهذا السّيناريو!
6 - الظُّلمةُ باهرةٌ ولا حاجة إلى الشّموع
“أيّتها الآلهة والنبوات والزعامات والمذاهب والعقائد والتعاليم… أيّتها الأشياء والكائنات-كلّ الأشياء والكائنات… ما أقلّ جمالك وأردأ حظوظك لولا الأكاذيب التي تهبك كلّ جمالك وكلّ حظوظك…”
–عبد الله القصيمي
“إنّ الحياة أمرٌ بائسٌ جدًّا، ولهذا قرّرت أن أقضيها في التأمّل فيها.”
-آرثر شوبنهاور
للمالينخولي السّعيد هوايات يُروّح بها عن نفسه مُنتظرًا ساعة خلاصه الأبديّ، ساعة انعتاقه من هذا العالم المجذوم، فصاحبُنا كائنٌ خاملٌ لا يُنجزُ شيئًا يستحقّ الذكر أو التخليد في سجلّات الإنسانيّة الحافلة، فلا تراهُ يُعلنُ حربًا إلّا على الرّيح، ولا يعِدُ بالإصلاحِ ولا يفكّر في مستقبل الأجيال القادمة ولا يأملُ في غدٍ أفضل ولا يُدخّنُ غليونًا فائحًا بعبق العدالة الاجتماعيّة ولا يزيّنُ رقبته بوشاح مُطرّز بالشِعر الأمميّ ولا يُغطّي رأسه بقبّعة مُبطّنة بالأفكار الخطيرة ولا يهرف بكلام مُهمٍّ أبدًا… إنّ هواية صاحبنا المفضّلة وتسليّته الأثيرة هي التلصّص على العالم من خلال ثقوبٍ افتعلها في جدران جُحرهِ الوجوديّ، لا غرض لهُ في ذلك سوى الاستمتاع بمشاهدة النيران التي تشبُّ كلّ حينٍ في مسرح العالم المنخور بالسّوس…
لا يُحبّذ المالينخولي السّعيد إشعال الشموع ولا يريد أن يحترق كي يُنير الطّريق، فهو لا يلعن الظّلام ولا يُعاديه، بل إنّ في نفس صاحبنا رغبة عارمةٌ في رؤية الظّلام مُخيّمًا في الأرجاء، ولكمْ يودّ أن يشهد ذلك اليوم الذي ستنطفئ فيه هذه النقطة الزّرقاء الباهتة –أمّنا الأرض- إلى الأبد، لتحلّ مكانها ظُلمةٌ باهرةٌ، وصمتٌ كونيٌّ جليلٌ يُمزّقهُ من حينٍ إلى آخر نجمٌ ثاقبٌ أو انفجار جرمٍ سماويّ. سوف يستمرّ الكون في الاشتغال بمنطقه الخاصّ غير عابئٍ بالسّخافات التي سطّرها الإنسان في سبيل فهمه وتأويله والسيطرة على قوانينه. لم يكتفِ الإنسان –ذلك الكائن الجُذاميّ، سوسة الأرض- بالنخر في هذا الكوكب المسكين، بل صار يبحث في إمكانات الحياة خارجه، علّه ينجح في تثبيت موطئ قدمٍ في كويكبٍ آخر كي ينتشر فيه كالورم الخبيث.
يُمضي المالينخولي السّعيد أيّامه الطّوال مُختلسًا النّظر إلى المهازل الكُبرى التي تُرتكبُ في حظيرة البشر، حيثُ يتصارع الجميع وسيقانهم غارقةٌ في المياه الآسنة، غير عابئين بنُتونة الجوّ وفساد الهواء، يتصارعون إلى أن ينتهي أمرهم غارقين في الوحل، فتتكدّس جثثهم المتعفّنة ليعتليها ورثتُهم ويُشيّدُوا من جماجم آبائهم صروحًا أخرى يعتلونها كي يُواصلوا من بعدهم مسيرةَ الخرابِ. لم يتّعظ النوع الإنساني من تاريخه البغيض، ذلك التّاريخ الذي اعتبره الحكيم إيميل سيوران ” لا شيء سوى تكرار للكوارث بانتظار الكارثة النهائيّة”، إنّ نظرةً أبوكاليبتيكيّة ثاقبة مثل هذه تُلخّص تاريخ العالم وتُعرّيه من جميع التأويلات المثاليّة التي ينسجها جراحوا تجميل الطّبيعة الإنسانيّة الفاسدة وصانعُوا الأقنعة البلاستيكية الباسمة.
ينظر المالينخولي السّعيد إلى المُتفائلين وصنّاع الأمل ضاحكًا مُتهكّمًا مُتعجّبًا من تلك القدرة الفريدة على تجاهل الفساد الأصلي المُستفحل في الطّبيعة الإنسانيّة، مُستغربًا من إصرارهم على الإصلاح والترميم والترميق والتزويق .يجعلون من الحياة قيمةً عُليا تستحقّ النضال والتّعب والكفاح والمعاناة، لقد قال صاحبنا في مناسبة سابقةٍ أنّ “الضّرر هائلٌ وجبرهُ صار محجوبًا عن الأفق” وقد تنبّه كاتب سفر الجامعة -المنسوب إلى سليمان ملك بني إسرائيل- إلى هذه الحقيقة الوجوديّة منذ آلاف السّنين فقال:”رأيتُ كلّ الأعمال التي عُملت تحت الشمس فإذا الكلُّ باطلٌ وقبضُ الريح، الأعوج لا يمكن أن يُقوَّم والنقص لا يمكن أن يُجبر”(سفر الجامعة، الأصحاح الأوّل).
ليست محاولات الإصلاح وازدهار سرديات الأمل سوى علامات انحطاط وقصور في استكناه الشرط الإنساني. إنّ أرقى ما يمكن أن يصل إليه عقلٌ بشريٌّ، هو ما وسمناه ب”إرادة الفناء”، تلك الإرادة التي تتحدّى “إرادة الحياة” المفروضة علينَا بيولوجيًا حتّى نُحافظ على بقاء النّوع، إنّ الثورة الوحيدة الممكنة في هذه الحالة هي الثورة على برمجتنا البيولوجيّة وتدمير خطط النظام الطّبيعي الأعمى والتخلّي عن أوهام الخلود الجيني ورفض تمرير المعاناة إلى جيل آخر، أمّا غير ذلك فهو ليس أكثر من مساهمة في استمرار تلك المهزلة /العاهة التي نُسمّيها “الحياة” .
إنّ فكرة الفناء الإراديّ والقول بأفضليّة العدم على الوجود والإقرار بعبثيّة الحضور الإنساني في الكون والخلوص إلى فساد الطّبيعة الإنسانيّة، هي قواعد وجوديّة أصيلة في محاولة فهم الشرط الإنساني، وقد حكمت هذه المقولات تمثُّلات العديد من الأنفس المالينخوليّة طيلة تاريخ الفكر، تلك الأنفس التي قالت لا في وجه حياة لا طائل منها ودعت إلى وقف المهزلة عبر رفض التّكاثر البشري والدعوة إلى مقاطعة الإنجاب، حتّى يتسنّى لنوعنا الفناء بأناقة دون حروبٍ نوويّة أو معارك ملحميّة مثل التي يروّج لها المنتمون إلى السرديّة التوحيديّة الإبراهيميّة(هرمجدون /الملحمة الكبرى /أبوكاليبس سفر رؤيا يوحنّا اللّاهوتي).
“خسِستِ، يا أمّنا الدّنيا، فأفّ لنا، – بنو الخسيسة أوباشٌ، أخسّاءُ ! ” – أبو العلاء المعرّي
“تاريخ العالم هو تاريخ الشرّ، جرّب أن تستثني الكوارث من التطوّر البشري- ستكون كمن يتصوّر الطّبيعة من دون فُصول.” – إميل سيوران
“تتأرجحُ الحياةُ كرقّاص السّاعة بين الألم والضّجر.” – آرثر شوبنهاور
كثيرًا ما يتردّد على مسامع صاحبنَا أنّ العالم في هذه الأيّام يتّجه نحو الهاوية، وأننّا نُزامنُ حقبةً رديئةً وأنّ أيّامنا هي الأسوأ على الإطلاق. لكنّ ما يلفت الانتباه حقًّا هو تردّد هذه العبارات تقريبًا في العصور كلّها وعلى ألسنة الأمم جميعها، حتّى أنّ الشاعر الرّوماني “جوڤـِنال” (توفي ق2م) ذكر في إحدى هجائياته “أنّنا وصلنا إلى الدّرجة القصوى في الرّذيلة، وأنّ من يأتون بعدنا لن يستطيعوا أن يتفوّقوا فيها علينا”. فهل يتّجهُ العالمُ صوب الهاويّة حقًّا؟ وهل النّكباتُ التي تحلّ بنا خاصّةٌ بعصرنا دون بقيّة العصور؟
… للمالينخوليّ السّعيد رأي آخر، إنّ العالم عينُهُ الهاوية، ونحنُ نقطنُ في قعرها، تلك الحُفرة السّحيقة التي نُدفعُ إليهَا دفعًا بالقوّة لا بالفِعل، بقوّة الآلة الطّبيعيّة العمياء التي تشتغل وفقًا لدوافع لا نُدركُها، لأنّها تقعُ خارج حُدود التمثّل الإنساني، كلّ ما ندركهُ أنّنا موجودون في قعر هذه الهاوية، منخرطون في طرق اشتغالها، تائهون في ثناياها، نخبطُ خبط العشواء في اللّيلة الظلماء ونُشاركُ في صناعة آلامنا وتأبيد معاناتنا، نُمنّي أنفسنا بغدٍ أفضل ونرفض الإقرار بأنّ بُؤسنا لن ينقضي إلّا بانقضاء نوعنا.
إنّ العالمَ مصنعٌ كبيرٌ لتكرير المعاناة وتأبيدها في عود أبديّ رتيب، تتغيّر الأزمنة وتتنوّع الأعراق وتتمايز الظّروف التّاريخيّة والثقافيّة، قد تتعدّد صيغ البؤس وتتفرّع معادلات الألم لكنَّ المعاناةَ واحدةٌ، إنّ هذا العالم ليس مكانًا للّراحة ولا للطُّمأنينةِ، إنّما هو ساحةٌ لخلق الحاجات والرّغبات التي لا تنتهي ولا تُشبع أبدًا، لا يكتفي الإنسانُ بالمُتاح ولا يشعر بالرّضا ولا يقرّ لمتطلّباته قرارٌ، بدءًا من أبسط احتياجاته وصولًا إلى أكثر رغباته ترفًا وفُحشًا، سيتألّمُ إنْ لم يُشبعها، وسيضجرُ سريعًا إذا قضى منها وَطَرًا، ليزداد من بعد ذلك تحرّقه إلى المزيد من مشتهيات نفسه ومآربها، لأنّ لحظة تحقيق الارتياح وملامسة اللّذّة تمرّ كلمح البرق . لقد أحسن شوبنهاور وصف هذا الوضع الوجوديّ حين قال:” تتأرجحُ الحياةُ كرقّاص السّاعة بين الألم والضجر. ”
يكُونُ العالم بمقتضى قانون الحاجات والرّغبات مسرحًا يخوض فيه الجميع الحرب ضدّ الجميع، حرب الأفراد على الأفراد والفرد على نفسه والنوع الاجتماعي على نظيره والأمم على الأمم والطوائف على الطّوائف والطبقات على الطبقات والنوع الإنساني على بقيّة الأنواع الحيّة، يتصارع الجميع من أجل سدّ حاجاتهم الجسديّة وإشباع رغباتهم المتجدّدة وانتزاع النّفوذ والهيمنة والمكانة والتفوّق وضمان ديمومة المصالح وتحقيق الأمن النفسي، إلى غير ذلك من متطلّبات النوع الإنساني التي تتجاوز منطق الحاجات الأساسيّة البسيطة، ذلك أنّ للإنسان رغبات بالغة التركيب ، مُشِطّة التعقيد ، يتعالق فيها العجيبُ والغريبُ واللّامُتوقّعُ، مثل أن يجلس سفّاحٌ إلى ضحيّته، يُقطّع أوصالها بدمٍ باردٍ، أو أن يُضحّي ملكٌ بجيش يُعدّ بالآلاف كي يحقّق رغبته في احتلال مدينة مجاورة أو أن يتلذّذ أحدهم بإلحاق الأذى بمن هم أضعف منه حالًا أو أن يستحمّ شخصٌ فاحش الثراء في حوض من الحليب والعسل كلّ يوم في حين يموتُ جارهُ جُوعًا وفقرًا…
ستطول القائمة إذا تمادينا في ذكر رغبات الإنسان الفاحشة، ذلك أنّ أنّها ليست من قبيل الشواذ من الأمور، بل هي مُحرّك التّاريخ الإنساني الرّئيس، ذلك التّاريخ الذي تحكمه الرّغبات والأهواء والأحلام والأمنيات الشخصيّة والمُصادفات والغباء وسوء التقدير، ذلك التاريخ الذي يُكتبُ في مقصورات الجواري وفي مجالس اللّهو والطرب وفي صالات القُمار وفي طموحات الزعماء الجامحة وفي هوامات المُجاهدين الجنسيّة وفي رُؤى الأنبياء الهاذية وفي مآرب أرباب الأموال الجشعة…
يُدركُ المالينخوليّ السّعيد أنّهُ عالقٌ في قعر هذا العالم/الهاويّة، ويعلمُ جيّدًا أن لا سبيل إلى تغييره أو إصلاحه، لذلك فهو لا يتّبع خطواته، بل يقبعُ آمنًا مُطمئنًّا في جحره الوجوديّ لا يغادره، يستيقظ كلّ يوم دون وجهة ولا هدف ولا غاية ولا سبب يدعوه إلى الانخراط في الحياة العامة، لقد قرّر الاكتفاء بتسطير الهجائيات، مهنته الوحيدة هي هجاء العالم وتعداد رذائله والتبرّؤ منه، وفي الأثناء يُصادِقُ الموت ويُغازلهُ، ويجدُ العزاء والسلوى في فكرة الفناء الأبديّ والعودة إلى ظلمات العدم، ف”لا مطلوب أبلغ من الموت” كما جاء على لسان ابن عربي.
إنّ هذا العالم سفينة سكرانة بلا ربّان، تتقاذفها أمواج الاحتياجات والرّغبات والأهواء والجُنون، وتُحاصرها شتّى العذابات والآلام، لا وجهة تنحو إليها ولا غاية تنشدُّ صوبها، لذلك فإنّ الانسحاب من الحياة العامة في هدوء لن يكلّفنا الكثير، بل إنّه المجد الوحيد الباقي، مجد الاستقالة من الوظائف الاجتماعيّة الباهتة، مجد الخروج من دوّامة الالتزامات التي لا تلزم، مجد الفرار من معركة نستبقُ خسارتها، مجد الحياة دون خوف ولا أمل ولا خيبات…
“نحنُ عبيدٌ ونبقى عبيدًا طالما لم نُشْفَ من عادة الأمل”… هكذا تحدّث الحكيم سيوران !
“لماذا خرجْتُ من الرّحمِ، لأرى تعبًا وحُزنًا فتَفْنى بالخزي أيّامي؟” – سفر إرميا
“يومُ المماتِ خيرٌ من يومِ الولادةِ” – سفر الجامعة
“ألهاكُم التّكاثرُ حتّى زُرتُم المَقَابِرَ” – سورة التّكاثر
لا يُعادي المالينخولي السّعيد أمرًا مثلما يُعادي الإنجاب/التّكاثر/التّناسل البشريّ، ولا يخفي اشمئزازه من التّكاثريين ولا استحقاره لكلّ من يدعو إلى الرمي بالمزيد من الحطب/الأطفال في هذه المحرقة/الحياة. يمثّل الإنجاب في نظر صاحبنا الجريمة الأصليّة، أمّا بقيّة الجرائم على فظاعتها فلا تزيد عن كونها مجرّد تنويعات على ذلك الأصل. لقد أقرَّ إميل سيوران بأنّ الشيء الوحيد الذي يفتخر به هو أنّه اكتشف في سنّ مبكّرة جدًّا أنّه لا يتعيّن على المرء أن يُنجب، واعتبرَ الآباء كلّهم مجرمين وغير مسؤولين، بل ذهب إلى اعتبار أنّ لقب “والد” هو أبشع الألقاب وأكثرها وحشيّة.
انتهى ألبير كامو في مقاله “أسطورة سيزيف” إلى أنّ الحياة تستحقّ أن تُعاش على عبثيّتها وخلوّها من كلّ معنى، وإلى أنّه يجب علينا أن نتخيّل سيزيف سعيدًا على شقائه الرّتيب وبؤسه الأبديّ، وذلك -تقريبًا- ما يسعى إليه المالينخولي السّعيد محاولًا جعل تجربته الخاصة محتملةً، لكنّهُ لا يقبل أبدًا أنْ يُوَرِّثَ تلك الصخرة السيزيفيّة أحدًا، إنّ الحياةَ ميراثٌ ثقيلٌ وليس من الأناقة الوجوديّة أن نفرْضه على كائنات/مُصادفات منويّة أخرى.
تفتحُ الحياةُ فوهتها مثل بالوعة تستقبلنا ثمّ تُصرّفَنا في ثناياها، لنشرع في الرّكض واللّهاث، نُشبه قوارض المجاري في تيهها بحثًا عن نقطة ضوءٍ، لكنّنا في النّهاية لن نظفر بغير الموت. يُقذفُ بنا إلى هذه المتاهة كي نموت ببطئٍ وسط ضجيج الوعّاظ الّذين يُبشّروننا بأنّ كلّ شيءٍ يحدث لسببٍ مّا، وبأنّ حكمةً مّا تكمنُ خلف كلّ تفصيلٍ، كأنّ هذا الكون يُبالي بنَا أو يقيم لنا حسابًا. لقد خٌيّل إلينا في لحظة مّا أنّ وجودنا على سطح هذا الكوكب أهمّ من وجود حفنة من القراد والبراغيث على ظهر كلب، لقد بالغنا كثيرًا في تقدير أنفسنا، وأظنّ أنّ الوقت قد حان كي نُراجعَ سُوءَ تقديرنَا مُراجعةً جذريّة تكفي لأن نقرّر التوقّف عن إعادة إنتاج نوعنَا، وأن ننصرف عن هذا الكون بكلّ أناقة قبل أن نُلفظَ منهُ بالقوّة. لن يُشفى الإنسان من إنسانويّته/مركزيّته إلا حين يقوم باختراق وعيه الواهم بنفسه وينسفه كُليًا؛ حين نتساوى أنطولوجيًا بالبقّ والعثّ والبراغيث وحين ندرك أنّ خلوّ الكون من نوعنَا ليس مأساة كوسمولوجيّة، لن ترثينا النجوم ولن تبكينا الكواكب ولن تُعلن المجرّات الحداد علينا.
كلّنا جئنَا من الخطيئة، لا أقصد “الجنس” باعتباره شبقًا/متعةً خالصةً، بل أتحدّث عن مآل تلك المتعة حين تُصيّرُ مسخًا بشريًا جديدًا، نسخة أخرى من فساد الطّبيعة، توقيعًا آخر على سجلّ المعاناة. ما الخطيئة الأصليّة إن لم تكنْ خطيئة الإنجاب؟ لماذا نُصرُّ على تأبيد الشّقاء؟ ألمْ يُلعنْ آدم في سفر التكوين حتّى عُوقبَ بالكدح والتّعب في سبيل العيش حين قيل لهُ “ملعونةٌ الأرض بسببكَ؟ ألمْ يُحكمْ على حوّاء بوظيفة الإنجابِ حكْمًا يوضع في مقام العقاب لا الهديّة حين قيل لها “تكثيرًا أكثّر أتعابَ حبَلكِ، بالوجعِ تلدينَ أولادًا”؟ ألم يُخلقْ “في كبدٍ” وفق العبارة القرآنيّة؟ ألم يُوصف بأنّهُ ظلومٌ جهولٌ حين تحمّل ما لا طاقة له بتحمّله؟ … ثمّة حُدوسٌ كامنةٌ في السرديّة الإبراهيميّة تُنبئنا بأنّ الحياة نفسها غلطة وخطيئة تحمّلها الإنسان ولا يزال مصرًّا على تحمّلها حتّى تأتيه السّاعة بغتة…
إنّ ما هو كامنٌ عند الإبراهيميين الرسميين، يظهرُ بجلاءٍ في قصصيات الشرق الأقصى وفي تعاليم الغنوصيين، لقد اعتبر بوذَا أنّ جوهر الحياة معاناة، فالولادة في الأدبيات البوذيّة هي منبع الألم الأوّل ومصدر الشّرور جميعها. واتّفقت كثيرٌ من مدارس أهل الغنوص على أنّ هذا العالم لا يمكن أن يكون من فعل إله خيّرٍ، بل هو من صنع/اختلاق قوى شرّيرة، دعا النّبي البابلي ماني إلى تجنّب الإنجاب، معتبرًا ذلك خطوة كبرى نحو الخلاص النهائيّ، واعتبر الانكراتيون (جماعة مسيحيّة غنوصيّة) أنّ وسيلة البشر لقهر الموت هي التوقّف عن الإنجاب. فالتكاثر في نظرهم وسيلة تغذّي الموت بتكثير المواليد الميتين حتمًا.
تُحذّر التعاليم الأبيقوريّة من اللّذّة التي يعقُبها ألم، مثل لذّة الخمر التي قد يعقبها ألم الصداع والغثيان، ما فات أبيقور هو أنّ الجنس أيضًا لذّة قد يعقبها كائنٌ جديدٌ، قربانٌ حيٌّ مجبول من الانتشاء لكنّهُ مُكرّس للألم وللمعاناة، معاناة لا تدوم سويعات قليلة مثل صداع الكحول، بل تدوم حياةً كاملةً، ولا تُؤذي صاحبها فحسبُ، بل تمتدّ إلى الكائنِ الجديد الذي أفرزته تلك العمليّة المتعويّة.
كلّ متعة تُؤدّي إلى إعادة إنتاج الإنسان، لا يُعوّل عليها؛ تُعتبرُ متعة الجنس -من وجهة نظر تطوّريّة- مُكافأة تمنحها إيّانا الطّبيعة حتّى يُحبّب إلينا الإنجاب وبالتّالي نضمن بقاء النّوع واستمراره، لقد تفطّنَ آرثر شوبنهاور إلى هذا الفخّ الطّبيعي الّذي تقعُ فيه الأنواع الحيّة، وأقرّ بأنّ الطّبيعة تضحّي بالفرد في سبيل النّوع، إنّ كلّ ذلك يجري من خلال قوّة “الإرادة” العمياء الّتي تدفعنا إلى التشبّث بالحياة وإلى تمريرها إلى الأجيال اللّاحقة، لكن وحده النّوع الإنساني قادرٌ على أن يغنمَ متعة الجنس دون أن يُحقّق غرضَ حفظ النّوع من الانقراض، والميزة الوحيدة الّتي يحقّ للإنسان أن يعتدّ بها أمام بقيّة الأنواع هي ميزة الرّفض؛ رفض “الإرادة” وبرنامجها البيولوجي العبثي الّذي لا يفضي إلّا إلى المزيد من شقاء الأحياء.
فيكتور هيغو
1 - كيف يحتمل السُّوداويُّ مُكوثه في العالم؟
ثمَّة من النَّاس من اختار انتهاج السُّوداويَّة رؤيةً للعالم ومقاربةً من مقارباته المتعدِّدة ومسلكًا جماليًا يعبُر تفاصيل الحياة وأفانينها،
والمالينخولي في الأصل إنسانٌ يائسٌ من العالم ومن النَّاس، ليس يأسهُ يأسًا رومنسيًا ساذجًا أو حالة انفعاليَّة عابرة، بقدر ما هو كينونةٌ تُنحتُ وتُؤَصَّلُ طيلة مكوثه في العالم.
تعرَّض ابن سينا في كتابه القانون في الطبِّ إلى المالينخوليا باعتبارها حالةً مَرضيَّةً مُحدِّدًا أعراضها قائلًا:
علامة ابتداء المالينخوليا ظنٌّ رديء، وخوفٌ بلا سبب، وسرعةُ غضبٍ، وحبُّ التخلي واختلاجٌ، ودوارٌ ودوىٌّ وخصوصًا في المراق. فإذا استحكم، فالتفزغُ وسوءُ الظنِّ، والغمُّ، والوحشةُ، والكَرب، وهذيانُ كلام، وأصنافٌ من الخوف مما لا يكون أو يكون.
وإذا كان تعامل ابن سينا وسائر النفسانيين مع المالينخوليا تعاملًا طبيًا اكلينيكيًا فإنَّنا نُقاربها خارج الفضاء الصحِّي، لذلك نختلف معهم في الرُّؤية العامَّة للحالة السُّوداويَّة-التَّشاؤميَّة-المالينخوليَّة من حيث اتِّفاقنا في تشخيص الأعراض.
حسم المالينخولي أمره مع مفردات من نوع: قصد، غاية، هدف، معنى، مطلق… ولم يعد يهمُّه ماذا يقع في الضفَّة الأخرى من العالم، ولا ما وقع في غياهب الماقبل، ولا ما سيقع في سرمد الماوراء.
كيف للإنسان أن يحتمل مكوثه في هذا العالم، لولا تلك الأضرب من الوهم الجميل (الفنُّ، المُثل العليَا، شرائع الخلاص المزعوم…)، عدا ذلكَ فإنَّ الحقيقة لا تُؤدِّي إلا إلى ثلاثة طُرق: اللَّامبالاة المطلقة (وهي درجة عُليا من الحصافة) أو الجُنون (وهو عينُ الوعي بالعالم) أو الانتحار…
ينتمي المالينخولي إلى سجلِّ اللامبالاة المطلقة، حيث الانتماء إلى اللاانتماء، وليس ثمَّة ما يدفعه إلى الانتحار، لأنَّ الانتحار عادةً ما يكون نتيجة خيبةٍ متأخِّرة. يقول إيميل سيوران في شذرة خاطفة:
لا ينتحر إلا المتفائلون، المتفائلون الذين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في التفاؤل. أما الآخرين فلماذا يكون لهم مبرر للموت وهم لا يملكون مبررًا للحياة.
المالينخولي كائنٌ سعيدٌ من شدَّة الحزنِ لأنَّ الحزنَ مصْلٌ مضادٌّ لنفسهِ، لا خشيةَ من شيءٍ إذنْ ولا أمل في شيءٍ، لا انتظارات ولا خيبات. يكفي الالتذاذ بما هو متاحٌ، لأنَّ اللِّذَّة مصدر كلِّ خير وفق المعلِّم “أبيقور”، والخيرُ كلُّ الخير في تجنُّب كلِّ ما يسبِّب الألم. تُعدُّ الإيتيقا الأبيقوريَّة وصفةً مثاليَّة لحياة المالينخولي السَّعيد: الالتذاذ في حدود المتاح، تجنُّب كلِّ ما يشكِّل مصدرًا للآلام، عدم الخشية من الموت ولا من القوَّة المفارقة، القدرة على تنسيب الألم والمصالحة معه.
يحاول المالينخولي الفكاك من كلِّ الارتباطات المحدَّدة بصفة قبليَّة، إذْ لا معنى للوطن فهو من قبيل المصادفة الجغرافيَّة، ولا معنى للعائلة لأنَّها مُؤسَّسةٌ على حتميَّات بيولوجيَّة، ولا معنى للعلاقات المبنيَّة على الانفعالات الطَّارئة والعرضيَّة. لذلك فإنَّه جازمٌ حازمٌ في مقاطعته لفكرة الزواج والتَّناسل؛ ففي زيادة النسل زيادةٌ في عدد الأشقياء. جاء في مصنَّف الدّراري في ذكر الذّراري لابن العديم الحلبي أنَّ فيلسوفًا سُئل: لم لا تطلب الولد؟ فقال: من محبَّتي للولد. وقيل لآخر: لو تزوَّجت فكان لك ولدٌ تُذكر به، فقال: والله ما رضيت الدنيا لنفسي فأرضاها لغيري.
لا يذهبنَّ في الظنِّ أنَّ المالينخولي السَّعيد داعية كراهيَّة أو صاحب نزعة تصفويَّة إباديَّة، فهو يفقد القدرة على الحبِّ والكره تدريجيًا خلال حياته القصيرة، لا شيء يستحقُّ الكره، كذلك بالنسبة إلى الحبِّ، كلُّ الموجودات سواسيَّة لأنَّها باطلةٌ بالأصالة وقبضٌ للرِّيح. الحياة عديمة الجدوى، وإذا وضعنا لها هدفًا على سبيل التجوُّز فإنَّه حتمًا سيكون الموت، لم يعد الموت مصدر خوف، بل هو صديق طيِّب للمالينخولي السَّعيد، وطيبته تكمن في حكمته المُعرِّيَّة للحياة.
يسخر المالينخولي من النَّوع الإنساني، بل ويشعر بالعار إذا تذكَّر انتماءه إلى هذا النَّوع، لذلك فهو محكومٌ في تمثِّله للعالم بـ”إرادة الفناء”، وتنزع هذه الإرادة إلى الإنهاء الوجودي للنوع الإنساني بعامة، حتَّى يعود النَّظام الطبيعي إلى مجراه، فالإنسان كائنٌ ناشزٌ، وقد تسبَّبَ نشوزه في إفساد العالم رغم التقدُّم الحضاري الظاهر. يقول جان جاك روسو في مقالته الرَّائدة في العلوم والفنون:
… وأنفسنا ازدادت فسادًا بقدر ما ازدادت علومنا وفنوننا كمالاً. أن يقول بعضهم إنَّها نكبة خاصَّة بعصرنا؟ كلَّا، يا سادتي، فالشُّرور الناجمة عن فضولنا الباطل إنَّما هي قديمة قدم العالم…
هل في نفس المالينخولي السَّعيد رغبةٌ في إصلاح ما قد فسدَ؟ كلا، إنَّ الضَّررَ هائلٌ وجبره صار محجوبًا عن الأفق. المالينخولي عدمي في المستوى الإيتيقي العام وفي مستوى السِّياسة. كلُّ تدبير للشَّأن العام هو تدبيرٌ للألم، وكلُّ سلطة تبدع مسخها الفرانكشتايني من حيث تدري ومن حيث لا تدري، فالأنظمة المجرمة كما يقول ميلان كونديرا:
لم ينشئها أناس مجرمون، وإنَّما أناس متحمِّسون ومقتنعون بأنَّهم وجدوا الطريق الوحيد الذي يُؤدِّي إلى الجنَّة.
قد يبدو المالينخولي السَّعيد متناقضًا في كثير من مزاعمه، فهو سعيدٌ من حيث حزنه، وموجودٌ من حيث إرادته للفناء، وعلاقاته الإنسانيَّة والعائليَّة طيِّبةٌ من حيث عدم إيمانه بأيِّ ضرب من الارتباطات! لكن التناقض الظَّاهر بالنسبة إليه ليس “نقصًا، أو خطأ، أو ضعفًا. إنه حركة حياة وكينونة. ورؤية عقلية متجددة” على عبارة عبد الله القصيمي، إنَّه حالة من القلق الدَّائم والارتياب اللَّامتناهي.
في ختام هذا المانيفستو، يريد المالينخولي السَّعيد بيان أنَّ لامبالاته غير ناجمة عن طيش أو فراغ وإنما هي حصافةٌ ورؤية للعالم واكتناه مباشر للألم الإنساني، فلا عزاء لهذا الألم إلا في فكرة فناء الإنسان ذاته باعتباره كائنًا مسيئًا إلى نفسه فضلاً عن إساءته إلى بقيَّة الموجودات.
صدق محمود درويش – وهو أحد الكائنات المالينخوليَّة السَّعيدة – إذ قال في سطرٍ شعري جميل جليل:
في اللَّامبالاة فلسفةٌ، إنَّها صفة من صفات الأمل.
2 - الوُجُودُ لَعِباً: تأمّلاتُ كائنٍ عابثٍ
مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ – الدّهريون العرب
بعدَ أن أضنتهُ التّجربة الوجوديّة وصار العبثُ بالنسبة إليه مذهبًا راسخًا، ارتأى المالينخولي السّعيد أن يضطلعَ بتدوين تأمّلات تكون بمثابة تأصيلٍ لكيانه. و قد تخيّر الكتابة على نحوٍ شذري/مقطعي بما يتلاءم مع مزاعمه و مصادراته، دون أن يتورّط في التشقيق المنطقي أو البناء النّسقي، فخارطته الوجوديّة تتشظّى و تتشقّق في انتظار السّقوط الأخير، و كذا نصّهُ.
ورد في لسان العرب أنّه يقال لكل من عَمِلَ عملاً لا يُجْدي عليه نَفْعاً: إِنما أَنتَ لاعِبٌ. يكُونُ الإله بناءً على هذا المعنى اللّغوي لجذر ( ل.ع.ب) أوّل كائنٍ لاعبٍ، باعتباره مُنشِئًا لوجودٍ لا يجدي عليه نفعًا و لا ضرًّا. تفطّن “أبيقور” إلى هذه اللّطيفة حينما أقرّ بأنّ الآلهة كائنات كاملة و مغتبطة و منزّهة عن كلّ ما عداها و مكتفيّة بذاتها ! و إذَا كانت حقًا كذلك، تكونُ آلهة لاعبة/عابثة بإيجادها للموجودات. لكن إذا أردنَا قَلْب المعادلة، و جعلْنَا المخْلوقَ مكانَ الخالقِ، لانْفكَّ اللُّغز و تنزّه الإله عن نقيصة اللّعب : لقدْ اخترعَ الإنسانُ الآلهة لحاجةٍ في نفسهِ، و بذلك ارتكب أوّلَ حماقةٍ فاصلةٍ في تاريخه : حماقةُ المعْنى/الغاية.
إذا كانَ العبثُ نقيصةً بالنسبة إلى الإله، فهو شرفُ الإنسانُ و أعلى تجلّيات وعيِه بذاته/حجمه/منزلته. لقد كانت فتوحات مُبينة تلك الكشوفات المعرفيّة التي خلخلت مسلّمات النوع الإنساني و قضقضت نرجسيّته كوسمولوجيًا و بيولوجيًا و سيكولوجيًا… لقد انبجست من تلك الثورات سرديّةُ الارتياب. و شرع الإنسانُ في إزالة السّحر/الوهم عن نفسه و عن العالم. لكنّهُ أعاد بناء أوهامه في سياقات علمويّة/وضعانيّة/حداثويّة أفضت به إلى الكارثة. و ماذا بعدَ الكارثة ؟ إنّها تباشيرُ فجرٍ جديد !… لقد عمّ الاستياء و الضّجر و الامتعاض و تفشّى اليأس و انتشرت اللّامبالاة و صارت الأرض حوضًا من حياض الجحيم يتقيّأ فيه غريبُ الأزمنة الحديثة… لقدْ وُلِدَ “اللّامنتمي” رسميًا !
وُلد اللّامنتمي بصفة رسميّة إبّان النّصف الأوّل من القرن العشرين، أي إبّان الكوارث الكونيّة المقنّنة و المُوَقّعة. و افتتح بولادته عصر العبث غير الخجول/ العبث الصّارخ، عصر إسدال السّتار عن كلّ التوهّمات الإنسانيّة، عصر تكشّف القُبح سافرًا مُتبرّجًا دون رياء. إنّ اللّامنتمي عينه الإنسان الأخير، دشّن بولادته بداية النّهاية، إنّهُ صوتٌ صارخٌ في البريّة الإنسانيّة، حيثُ الوحشةُ و اصطكاك الأسنان. إنّ عصر اللّامنتمي عينه عصر تجلّي الرّوح الكلّي الحقيقي و انكشافه – لقد خسر هيغل الرّهان -، عصر ظهور الذئب نازعًا عنه ثياب الحمل الطّيب الأخلاقي، لا مطمع بعد في أساطير الخلاص والمخلّصين، ولا إيمان بعد في غائيّة التّاريخ و نبل مقصده، و لا اعتقاد بعد في العناية الإلهيّة.
يقوم الإدراك الإنساني على الفنطاسيا أو التّوهّم، فهو تمثّلي في كنهه. و بالعودة إلى مصنّف شوبنهاور “العالم إرادةً و تمثّلًا” – يُعتبر من روافد المالينخولي السّعيد الكلاسيكيّة – ، نعثر على هذه الفكرة بوضوح : فالإنسان“لا يعرف شمسًا و لا أرضًا، و إنّما يعرف فقط عينًا ترى شمسًا و يدًا تحسّ أرضًا، و أنّ العالم الذي يحيط به إنّما يكون قائمًا هناك بوصفه تمثّلًا فحسب”. تنتفي وفق هذا التقرير أسطورة تطابق المقول بالمعقول بالمحسوس. فالإنسانُ كائنٌ واهمٌ بالضّرورة، لا يرى إلّا ما تسمح له حواسه الخادعة برؤيته و لا يتمثّل إلّا ما يمليه عليه ذهنه المحكوم بإكراهات البيولوجيا ( قد يتسبّب الفصام مثلا -و هو مرض عضوي يصيب الدّماغ – في هلاوس سمعيّة لا وجود لها في العالم الحقيقي ) . يكون التّمثّل إذنْ لعبةً موغلة في الفردانيّة، شكل من العبث بالوجود و تشكيله و قولبته كالطّين الأملس.
يقول المالينخولي السّعيد في إحدى يوميات خيبته : “ماذا أفعل في هذا العالمِ ؟
أستيقظ كلّ يوم على وقع هذا السّؤال المُربكِ. تُعاوِدُني الرّهانات الكانطيّة بخصوص المنزلة و الواجب و الرّجاء و المعرفة.
ماذا يمكنني أن أعرف ؟
يكفي أنّي عرفتُ الخيبةَ تتكرّرُ في التّاريخ و في أنحاء الرّوح.
ماذا يجب عليَّ أن أفعلَ ؟
أنا سليل المنهزمين النّاعقين المبشّرين بخراب العالمِ و بطلانه. من سليمان الحكيم مرورًا بالمعرّي وصولًا إلى إيميل سيوران، أنا تلك البومة الوديعةُ، نذيرُ الشُّؤمٍ علامةُ الحكمةِ.
ما الذي يجوز لي أن آمل ؟
كلُّ تقنيات الرّجاء استنفذت إمكاناتها، أكتفي بترديد تلك الحكمة البوذيّة المحفورة على شاهد قبر نيكوس كازانتازاكيس، ”لا آمُل في شيء، لا أخشى شيئًا، أنا حرٌّ “. ما الإنسان ؟ الإنسانُ كائنٌ مسخٌ، يبدعُ أصفادًا إذا أطلّ الصبحُ ثمّ يحاول الفكاك منها سرًّا إذا وقبَ الغاسقُ، يبذلُ الجهد الجهيد موسمَ الحصاد ثمّ يحرقُ السّنابل ليشرعَ في الحربِ على الفُتاتِ، ضبعٌ يقتات على جيفة بني جنسهِ، ذئبٌ لأخيه، حفّارٌ للقبور الباذخة، طمِعٌ في حياةٍ فوقَ الحياةِ، حقودٌ حسودٌ ميّالٌ إلى الشرِّ نزّاعٌ إلى الأذيّة…
تلكَ طريقتي في تَصْريفِ النّكدِ اليوميِّ، و كلُّ ما أبوحُ بهِ تنويعٌ على هذا القولِ الجللِ : باطِلُ الأَبَاطِيلِ،الْكُلُّ بَاطِلٌ وَقَبْضُ الرِّيحِ. ( سليمان الحكيم – سفر الجامعة )”
3 - رجل لا يدري ويدري أنَّه لا يدري
“وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ” – قرآن كريم ( سورة الأنبياء )
“لَيْتَ كَرْبِي وُزِنَ، وَمَصِيبَتِي رُفِعَتْ فِي الْمَوَازِينِ جَمِيعَهَا، لأَنَّهَا الآنَ أَثْقَلُ مِنْ رَمْلِ الْبَحْرِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ لَغَا كَلاَمِي.” – الكتاب المقدّس (سفر أيّوب )
لماذا تحدث أشياء ضارة ؟ قال المالينخولي السّعيد و قد استبدّ به الحزنُ، كأنّه يحمل ثقل العالم وآلامه. لماذا يتألّم الإنسان؟ لماذا يقع فريسةً لتقلّبات الحياة؟… هكذا انسابت الأسئلة في ذهن صاحبنا و تبدّت له في شكل معضلات تعصى على الاستيعاب. ثمّ استعاد معضلة الشرّ التي أثارها أبيقور وارتفعت من بعده إلى مقولة دهريّة غالبًا ما يضمّنها الهراطقة والزنادقة في سجالاتهم ضدّ حرّاس العقائد وزبانية القداسة، إذ كيف يحدث الشرّ في العالم تحت عناية ربٍّ رحيمٍ؟ لماذا يصابُ الرُّضّعُ بالأدواء المزمنة؟ لماذا تنزل الكوارثُ بالبشر فتخبطهم خبط عشواء؟ لماذا لا تتكافأ الفُرص في الأعمار و الأرزاق…؟
يمكننا أن نزعم أنّ معضلة الشرّ هي الحجّة الأخلاقيّة الأقوى التي تدحض عقيدة العناية الإلهية، ورغم كلّ الرّدود الثيولوجيّة الغارقة في التبرير الفلسفي لمشكلة الشرّ ( الثيوديسيا ) إلّا أنَّها لا تصمد أمام تألّم صبيّ واحدٍ مصابٍ بداء عضال، ويمكن لكلّ اللّاهوتيات الدّفاعيّة ( الأبولوجيا ) أن تتهاوى أمام دمعة أمّ منكوبةٍ. لذلك أمكن لنا أن نخلص إلى مسلّمة مفادها أنّ العالم مُهملٌ ضدًّا على مبدأ العناية، وأنّ الطّبيعة قوّة عمياء لا تساير الإنسان ولا تخضع لمعاييره الأخلاقيّة، وأنّ حياة الإنسان محكومة بالصّدفة. إنَّ الحياة لعبة نرد، وما ثنائيّة الخير والشرّ ويا ينجرّ عنها من مفاهيم كالعدالة والقضاء والقدر والثواب والعقاب والابتلاء إلّا عزاءٌ ابتدعه الإنسان كي يبرّر بقاءه.
وُلدت ثنائيّة الخير والشرّ بسبب الاعتقاد في ما أسماه نيتشة “وهم العوالم الخلفيّة”، أي الاعتقاد في وجود كينونة متعاليّة خفيّة عن عالم الظواهر، و بناءً عليه فإنّ لكلّ حدث يقع في عالم الظواهر سببًا خفيًّا ينجرُّ رأسًا عن العوالم الخلفيّة ولا يكون إلّا تجلّيًا من تجليات القوّة الخفيّة وعيّنة ظاهرة من حقيقتها. مثلا : حين يضرب زلزالٌ منطقة ما، سيُفسّر الأمر بأنّه عقابٌ من القوى الإلهيّة لأهل تلك المنطقة بسبب خطيئة اقترفوها أو اقترفها بعضهم أو سيفسّرُ بأنّه ابتلاءٌ لاختبار إيمانهم وصمودهم أمام قدر الآلهة و قضائها. وبالتّالي تُضفى على الزلزال صبغة أخلاقيّة باعتباره تحقيقًا لعدالة الآلهة بين البشر في حين أنّه لا يتعدّى أن يكون حدثًا طبيعيًا تحكمه قوانين وسلسلة من الأسباب. إنّ قانون السّببيّة لا يعرف خيرًا ولا شرًّا، ولا يهمّه أنّ يحقّق عدلًا في عالم الإنسان، ولا يدلّ على إرادة فوقيّة، بل إنّه لا يدلّ إلّا على نفسه.
الإنسانٌ مُلقى على قارعة الكون، مُهملٌ ومتروكٌ للعدم، ليس ثمّة من يهتمّ لأمره غيره، ينبغي أن نتقبّل هذه الحقيقة كي نستطيع الصّمود أمام ما يحدق بنا من كوارث و آلام. علينا أن نستوعب أنّنا موجودون هكذا من دون مبرّر، نستمرّ في الحياة بسبب ضعفنا، و نموت عن طريق المصادفة وفق العبارة السّارتريّة. إنّ حياتنا مشرّعة على كمّ هائل من الممكنات المحكومة بثنائيّة المصادفة والسّببيّة. ولشرح ذلك يمكننا أن نضرب المثال التّالي : أن يكون زيد موجودًا في المنطقة ( أ ) وفي السّاعة ( ب )، وقد تزامن ذلك مع وقوع زلزال في السّاعة نفسها و المنطقة نفسها، وكان زيد من ضحايا ذلك الزلزال و لقي حتفه. في سيناريو آخر كان من الممكن أن يلزم زيد بيته ذلك اليوم وبالتّالي كان يمكن أن يسلم من الزّلزال، لكن تزامن وجوده في المنطقة ذاتها و الساعة ذاتها أدّى إل هلاكه. لذلك قلنا أنّ الممكنات محكومة بثنائيّة المصادفة ( تزامن وجود زيد وحدوث الزلزال في المكان نفسه ) والسّببيّة ( الزلازل تحدث نتيجة الإزاحات في الصّفائح التكتونيّة ). في ذلك اليوم الذي هلك فيه زيد بسبب الزّلزال بكت أمّ زيد وانتحبت مخمّنةُ أنّ موت ابنها كان بسبب قوى شرّيرة استهدفته، وخمّن بعض معارف زيد أنّ موته بتلك الطّريقة كان انتقامًا من الله بسبب بعض خطاياه.
استوعب المالينخولي السّعيد أنّ ما نسمّيه شرًّا، لا معنى له في عالم الظّواهر، وأنّ كلّ ما يحدث للإنسان من أمراض و أوبئة ومجاعات وكوارث طبيعيّة لا يمكن أن ندينها أخلاقيًا لأنّها لا تسير وفق إرادة معيّنة، ولا تستهدف أفرادًا أو مجموعات بشريّة وفق خطّة معيّنة، فكلّ ما يحدث يحدث من دون غائيّة أو ماهيّة أخلاقيّة مُحدّدة سلفًا. وعلى الإنسان أن يحاول الحدّ من الأضرار والتخلّص من أكبر قدر ممكن من الألم في خضمّ المصادفات والكمّ الهائل من الممكنات. وعلينا دائمًا أن نضع تلك الوصفة الأبيقوريّة نصب أعيننا : القدرة على تنسيب تجربة الألم ومسايرته والمصالحة معه… ويبقى العزاء الأخير للإنسان في كون الحياة فانية عاجلًا أو آجلًا.
4 - اعتزالُ الفِتَنٍ
“تُحدّثُونني عن أنباءِ السّياسةِ. لو عرفتُم كمْ أنا غير عابئٍ بها! لم ألمسْ صحيفةً مُنذُ أكثر من سنتين. كلّ هذه السجالات تبدو لي الآن متعذّرة على الفهم …” – آرثر رامبو
“أيّها المالينخولي السّعيد، توقّف عن حيادكَ الجبان، وجِدْ لكَ موقفًا من هذه الحرب القائمة بين قوى الظّلام وقوى النّور في عالمنَا، إنَّ عالمنا هو الأفضل بين العوالم الممكنة، وليس بالإمكان ما هو أبدع منه، فدعْ عنكَ جُبنكَ وسلبيّتكَ وخُضْ الحرب إلى جانب الحقِّ، إلى جانبنا نحنُ، وإلّا فإنّكَ محسوبٌ على أعداء الحقّ، أعدائنَا …”
كثيرًا ما يسمع المالينخولي السّعيد مثل هذه الخطب الوعظيّة من أصحابه ومعارفه، محاولين استدراجه إلى اتّخاذ موقفٍ سياسويّ مباشرٍ أمام ما يحدث في العالم من أهوال، مُوهمين إيّاه أنّ الحقَّ في قبضة طرفٍ بعينه، وأنَّ الشرّ من اختصاص عدوّ ذلك الطّرف، وأنّ الحرب بينهما حربٌ بين حقّ و باطلٍ، وإذا لم تخترْ الحقَّ فإنّكَ حتْمًا من أهل الباطل.
هكذا يتمُّ تصنيفُكَ والانتهاء منكَ بوضعك في أحد رفوف البؤس الإيديولوجيّ، فصمتُكَ يثير رعدتهم، إنّهم يهابُونَ غموضكَ وفرادتكَ ولا تقرّ لهم عينٌ إلّا بعد التَّأكّد من موقعكَ: إمّا معهم أو ضدّهمْ. لا يمكنكَ أن تقطُنَ خارج منطقتهم المانويّة، ومنطقهِمْ الثَّنائي القائم على تقسيم العالم تقسيمًا بدائيًّا لم يتجاوز ثنائيّات نحنُ وهُم والخير والشرّ والنّور والظَّلام والرَّحمن و الشَّيطان …
إنّ كمّاشة “الإحراج الُّثنائي الزّائف” آلةٌ ذهنيّةٌ صدئة، بها يحاولونَ اقتلاع المالينخولي السّعيد من الموقعْ الَّذي تخيّرهُ لنفسه حتّى يتسنّى لهمْ رؤيته بوضوحٍ، فإذا كانَ ضدّهم يُحاربونَهُ، وإذا كان معهُم يجنّدونهُ كي يُحارب إلى جانبهم، لكنَهم لا ينالون مُرادهُم لأنّهُ عصيٌّ على التَّصنيف، إنّهُ كائنٌ مُوغلٌ في فردانيّته ولا يستطيع أن يكونَ حطبًا في محرقةٍ لا تعنيه، ولا جنديًا في حربٍ يُعلِنُها الأباطرة ويُسحقُّ فيها سِفلةُ النّاس ومُغرَّرُوهم.
يُشدّدُ المالينخوليُّ السَّعيد على فردانيّته، فهي تُعدُّ من فضائله الَّتي يسلُكُ حياتَهُ وفقهَا، فصاحِبُنا منهمٌّ بذاته مُنشغلٌ بها، لا يطلب غير ملذّاته وسكينته، ذلك أنَّ حياته قصيرةٌ ولا تتّسعُ لأنْ يُهدرها في النّضال من أجل قيمٍ ومُثلٍ مُحالٌ إشاعتُها في عالمٍ تغلبُ عليهِ نزعاتُ العُنف والجشعِ، كيف يُمكنُ الاصطفاف خلفَ قائدٍ، أو زعيمٍ، أو سياسيٍّ يتبنّى مقولات مثل الأمّة والقوميّة والهويّة والدّين وصناعة المجد ويُتاجر بها في سوق المُثل العُليا والقيم الخالدة؟ لقد اُستغلّت هذه المقولات طيلة تاريخ النّوع الإنسانيّ من طرف أصحاب السّلطتين الزّمانيّة والرّوحيّة، وكُتبتْ الملاحم والأمجادُ بدماء الجماعات الَّتي وهبت نفسها فداءً لانتماءاتها، لكنَّ المالينخولي السّعيد يأبى أن يكونَ بيدقًا يخدمُ لحساب الشّاه على حسابِ سعادتهِ الفرديّة.
لن ينتهي بُؤسُ الإنسانِ إلّا بانقضاء نوعه، ولنْ تخمُدَ نارُ المحرقة دون التَّوقّف عن إيقادها، ولنْ تنتهي “الفِتَنُ” إلّا باعتزالها، هذا ما استقرّ عندهُ رأيُ صاحبنا، لمْ يتراجع المالينخولي السّعيد عن مواقفه الَّتي سجّلها في مناسبات سابقةٍ: مُعاداةُ التّناسل واليأس من الإنسان وإرادة الفناء والاستقالة من الحياة العامّة واعتزال القضايا الكُبرى والتَّمسّك بملذّاته الفرديّة البسيطة، تلكَ هي فضائله الَّتي يُصرّفُ من خلالها حياتهُ العرضيّة.
5- مانيفستو الموت السّعيد
“و الموتُ ليس برديءٍ. إنّما خوفُ الموتِ رديء” – الكِنْدي
“… غلِطت الأنفسُ-الضعيفة التمييز المائلة إلى الحسّ- في الموتِ، وظنّتهُ مكروهًا، وهو ليس بمكروهٍ” – الكِنْدي
الموتُ، ذلك العدوّ البغيض للنوع الإنسانيّ، هادمُ اللذّات الأشدّ إبهامًا بالنسبة إلى المعرفة البشريّة، يُثير رعدة الحاضرين أينما ذُكرَ إسمه، و يفزع له النّاس لمجرّد التفكير فيه أو تخيّله ، حُبّرت في ذكره الأسفار المقدّسة وحيكت من أجل فكّ سرّه حكاياتُ الأصلِ و مواعظُ المعاشِ و أساطيرُ المعادِ، و للموت أيضًا طقوسه و شعائرهُ التي لا تخلو منها ثقافةٌ مهما كانتْ “بدائيّةً” وفق تصنيف البعض. لكن ما الذّي يمكنُ للإنسان أن يجزمَ بمعرفته ؟ الإجابةُ محلّ اتّفاق بين أهل الإيمان وأهل العلم: “قُلْ إنّ الموتَ الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم”، و الموتُ أيضًا واقعة بيولوجيّة لا ريب فيها.
ماذا يعني أن نقرنَ السّعادة بالموت؟ و كيف يكونُ الموتُ سعيدًا؟ و هل بإمكاننا كتابةُ بيانٍ في مديح الموتِ؟ قد يبدو من غير الشائع أن نتحدّث عن الموت مقرونًا بالسّعادة إلّا في حالة الحديث عن السّعادة الأبديّة ، لكنَّنا نعلم أنّ المالينخولي السّعيد يقطعُ مع كلّ مفهوم أخرويٍّ، و أنَّ تأمّلاته و أفكارهُ منشدّة إلى ال”هُنا” لصيقةٌ با”لآن”. إنّ الأمرَ راجعٌ إلى نظرته إلى حياته، فهو ليس متعلّقًا بها ، بل هو رافضٌ لها بالأصالة و مستوعبٌ لعرضيّتها و مُرحّبٌ بحتميّة فنائها، لذلكَ فإنَّ صاحبنا لا يهابُ الموتَ بل يُصادِقُهُ و يُصالِحُهُ.
يُعرّف الفيلسوف الكِنْدي الحُزنَ بأنّهُ ” ألمٌ نفسانيٌّ يعرضُ لفقْدِ المحبُوباتِ و فوْتِ المطلوبَاتِ “، و الحياةُ بالنسبة إلى صاحبنا ليست بمحبوبةٍ و لا هي بمطْلوبةٍ، بل هي حُفرةٌ فارغةٌ و باردةٌ قُذفَ إليها قسرًا، لذلكَ فإنّ واقعة الموتِ واقعةٌ سعيدةٌ لأنّها خلاصٌ من هذا الوجودِ القسريِّ. تشكّلُ حادثة الولادة بداية مأساة الكائنِ المالينخوليِّ، أمّا الموتُ فإنّهُ أكثر النهايات الممكنة سعادةً لتلك المأساة. لقد أحسنَ الحكيمُ إيميل سيورانْ نقلَ هذه الفكرة حينَ قال:” نحنُ لا نركضُ نحو الموت، نحنُ نفرّ من كارثة الولادة”.
يُعدُّ الخوفُ من الموتِ حائلًا دونَ المُصالحة معهُ، هذا ما نتعلّمُهُ من الدّرس الأبيقوريّ، فالمعلّم أبيقور لا يرى في الموت ما يستدعي الخوف أو القلق، لأنّ الموت يقع في منطقة “اللّاوجود”، و تلك المنطقة لا تعنينا لأنّنا لا نقع في نطاقها، إنّ الموت “لا شيء بالنسبة إلينا ، إذْ عندما نكونُ فالموتُ لا يكونُ” لأنّهُ بمثابة فقدانٍ كلّي للإحساس، تلك هي خلاصة الدّرس الأبيقوريّ . لذلك ينبغي أن نتقبّل فكرة فنائنا في طُمأنينة ، فالموت يعني انعتاقنا من آلام الجسد و من مخاوف الفكر و من تقلّبات الحظّ.
لقد بات الموتُ موضوع تهكّم المالينخولي السّعيد بدلًا من أن يكون مصدر مخاوفه، فحدثُ الموتِ هو غايةُ العبث و مآلُ كلّ تعب الإنسان. يكفي أن تقف متأمّلًا أمام إحدى المقابر حتّى يتبيّن لكَ انعدام الجدوى، كلُّ قيمةٍ هي معدومةٌ أمام الموتِ. ليست هذه دعوة زهديّة و لا وعظة أخلاقيّة، إنّما هي لحظةٌ تُسفَّهُ فيها كلّ الأحزان المتعلّقة بالحياة اليوميّة و تفاصيلها السّمجة. إنّ لحظةَ المصالحة مع الموت هي لحظة تحرّر الإنسان من جميع مخاوفه وآماله.
ليس الموت بالحادثة الجليلة ولا هو بالواقعة المهيبة، لقد بات جديرًا بالكائن الإنسانيّ أن ينقُشَ على شاهدة قبره الكبير -تلك الحفرة الباردة ، أُمُّنا الأرض- تقريرًا عن تفاهة الموت و برودته. فأنْ ننتهي في فراشٍ تُرابيٍّ رطبٍ حيثُ نتحلّلُ بفعل البكتيريا ونهم الدّيدان، لا تزيد هذه النهاية التّراجيديّة عن كونها عمليّة بيولوجيّة صغيرة منخرطة في نظام اشتغال آلة الطّبيعة العمياء. تتبدّى “تفاهة الموت” جليّةً للناظر إذا ما فُكَّ عنهُ ذلك السّحر و نُزِعتْ عنهُ أهوامُ العوالِم الخلفيّة وأساطير الحيواتِ البَعْديّة.
حياةٌ ثُمّ موتٌ ثمّ… لاشيء! ما أشدّ غبطة المالينخوليّ السّعيد بهذا السّيناريو!
“أيّتها الآلهة والنبوات والزعامات والمذاهب والعقائد والتعاليم… أيّتها الأشياء والكائنات-كلّ الأشياء والكائنات… ما أقلّ جمالك وأردأ حظوظك لولا الأكاذيب التي تهبك كلّ جمالك وكلّ حظوظك…”
–عبد الله القصيمي
“إنّ الحياة أمرٌ بائسٌ جدًّا، ولهذا قرّرت أن أقضيها في التأمّل فيها.”
-آرثر شوبنهاور
للمالينخولي السّعيد هوايات يُروّح بها عن نفسه مُنتظرًا ساعة خلاصه الأبديّ، ساعة انعتاقه من هذا العالم المجذوم، فصاحبُنا كائنٌ خاملٌ لا يُنجزُ شيئًا يستحقّ الذكر أو التخليد في سجلّات الإنسانيّة الحافلة، فلا تراهُ يُعلنُ حربًا إلّا على الرّيح، ولا يعِدُ بالإصلاحِ ولا يفكّر في مستقبل الأجيال القادمة ولا يأملُ في غدٍ أفضل ولا يُدخّنُ غليونًا فائحًا بعبق العدالة الاجتماعيّة ولا يزيّنُ رقبته بوشاح مُطرّز بالشِعر الأمميّ ولا يُغطّي رأسه بقبّعة مُبطّنة بالأفكار الخطيرة ولا يهرف بكلام مُهمٍّ أبدًا… إنّ هواية صاحبنا المفضّلة وتسليّته الأثيرة هي التلصّص على العالم من خلال ثقوبٍ افتعلها في جدران جُحرهِ الوجوديّ، لا غرض لهُ في ذلك سوى الاستمتاع بمشاهدة النيران التي تشبُّ كلّ حينٍ في مسرح العالم المنخور بالسّوس…
لا يُحبّذ المالينخولي السّعيد إشعال الشموع ولا يريد أن يحترق كي يُنير الطّريق، فهو لا يلعن الظّلام ولا يُعاديه، بل إنّ في نفس صاحبنا رغبة عارمةٌ في رؤية الظّلام مُخيّمًا في الأرجاء، ولكمْ يودّ أن يشهد ذلك اليوم الذي ستنطفئ فيه هذه النقطة الزّرقاء الباهتة –أمّنا الأرض- إلى الأبد، لتحلّ مكانها ظُلمةٌ باهرةٌ، وصمتٌ كونيٌّ جليلٌ يُمزّقهُ من حينٍ إلى آخر نجمٌ ثاقبٌ أو انفجار جرمٍ سماويّ. سوف يستمرّ الكون في الاشتغال بمنطقه الخاصّ غير عابئٍ بالسّخافات التي سطّرها الإنسان في سبيل فهمه وتأويله والسيطرة على قوانينه. لم يكتفِ الإنسان –ذلك الكائن الجُذاميّ، سوسة الأرض- بالنخر في هذا الكوكب المسكين، بل صار يبحث في إمكانات الحياة خارجه، علّه ينجح في تثبيت موطئ قدمٍ في كويكبٍ آخر كي ينتشر فيه كالورم الخبيث.
يُمضي المالينخولي السّعيد أيّامه الطّوال مُختلسًا النّظر إلى المهازل الكُبرى التي تُرتكبُ في حظيرة البشر، حيثُ يتصارع الجميع وسيقانهم غارقةٌ في المياه الآسنة، غير عابئين بنُتونة الجوّ وفساد الهواء، يتصارعون إلى أن ينتهي أمرهم غارقين في الوحل، فتتكدّس جثثهم المتعفّنة ليعتليها ورثتُهم ويُشيّدُوا من جماجم آبائهم صروحًا أخرى يعتلونها كي يُواصلوا من بعدهم مسيرةَ الخرابِ. لم يتّعظ النوع الإنساني من تاريخه البغيض، ذلك التّاريخ الذي اعتبره الحكيم إيميل سيوران ” لا شيء سوى تكرار للكوارث بانتظار الكارثة النهائيّة”، إنّ نظرةً أبوكاليبتيكيّة ثاقبة مثل هذه تُلخّص تاريخ العالم وتُعرّيه من جميع التأويلات المثاليّة التي ينسجها جراحوا تجميل الطّبيعة الإنسانيّة الفاسدة وصانعُوا الأقنعة البلاستيكية الباسمة.
ينظر المالينخولي السّعيد إلى المُتفائلين وصنّاع الأمل ضاحكًا مُتهكّمًا مُتعجّبًا من تلك القدرة الفريدة على تجاهل الفساد الأصلي المُستفحل في الطّبيعة الإنسانيّة، مُستغربًا من إصرارهم على الإصلاح والترميم والترميق والتزويق .يجعلون من الحياة قيمةً عُليا تستحقّ النضال والتّعب والكفاح والمعاناة، لقد قال صاحبنا في مناسبة سابقةٍ أنّ “الضّرر هائلٌ وجبرهُ صار محجوبًا عن الأفق” وقد تنبّه كاتب سفر الجامعة -المنسوب إلى سليمان ملك بني إسرائيل- إلى هذه الحقيقة الوجوديّة منذ آلاف السّنين فقال:”رأيتُ كلّ الأعمال التي عُملت تحت الشمس فإذا الكلُّ باطلٌ وقبضُ الريح، الأعوج لا يمكن أن يُقوَّم والنقص لا يمكن أن يُجبر”(سفر الجامعة، الأصحاح الأوّل).
ليست محاولات الإصلاح وازدهار سرديات الأمل سوى علامات انحطاط وقصور في استكناه الشرط الإنساني. إنّ أرقى ما يمكن أن يصل إليه عقلٌ بشريٌّ، هو ما وسمناه ب”إرادة الفناء”، تلك الإرادة التي تتحدّى “إرادة الحياة” المفروضة علينَا بيولوجيًا حتّى نُحافظ على بقاء النّوع، إنّ الثورة الوحيدة الممكنة في هذه الحالة هي الثورة على برمجتنا البيولوجيّة وتدمير خطط النظام الطّبيعي الأعمى والتخلّي عن أوهام الخلود الجيني ورفض تمرير المعاناة إلى جيل آخر، أمّا غير ذلك فهو ليس أكثر من مساهمة في استمرار تلك المهزلة /العاهة التي نُسمّيها “الحياة” .
إنّ فكرة الفناء الإراديّ والقول بأفضليّة العدم على الوجود والإقرار بعبثيّة الحضور الإنساني في الكون والخلوص إلى فساد الطّبيعة الإنسانيّة، هي قواعد وجوديّة أصيلة في محاولة فهم الشرط الإنساني، وقد حكمت هذه المقولات تمثُّلات العديد من الأنفس المالينخوليّة طيلة تاريخ الفكر، تلك الأنفس التي قالت لا في وجه حياة لا طائل منها ودعت إلى وقف المهزلة عبر رفض التّكاثر البشري والدعوة إلى مقاطعة الإنجاب، حتّى يتسنّى لنوعنا الفناء بأناقة دون حروبٍ نوويّة أو معارك ملحميّة مثل التي يروّج لها المنتمون إلى السرديّة التوحيديّة الإبراهيميّة(هرمجدون /الملحمة الكبرى /أبوكاليبس سفر رؤيا يوحنّا اللّاهوتي).
7 -العالمُ عينُهُ الهاوية
“تاريخ العالم هو تاريخ الشرّ، جرّب أن تستثني الكوارث من التطوّر البشري- ستكون كمن يتصوّر الطّبيعة من دون فُصول.” – إميل سيوران
“تتأرجحُ الحياةُ كرقّاص السّاعة بين الألم والضّجر.” – آرثر شوبنهاور
كثيرًا ما يتردّد على مسامع صاحبنَا أنّ العالم في هذه الأيّام يتّجه نحو الهاوية، وأننّا نُزامنُ حقبةً رديئةً وأنّ أيّامنا هي الأسوأ على الإطلاق. لكنّ ما يلفت الانتباه حقًّا هو تردّد هذه العبارات تقريبًا في العصور كلّها وعلى ألسنة الأمم جميعها، حتّى أنّ الشاعر الرّوماني “جوڤـِنال” (توفي ق2م) ذكر في إحدى هجائياته “أنّنا وصلنا إلى الدّرجة القصوى في الرّذيلة، وأنّ من يأتون بعدنا لن يستطيعوا أن يتفوّقوا فيها علينا”. فهل يتّجهُ العالمُ صوب الهاويّة حقًّا؟ وهل النّكباتُ التي تحلّ بنا خاصّةٌ بعصرنا دون بقيّة العصور؟
… للمالينخوليّ السّعيد رأي آخر، إنّ العالم عينُهُ الهاوية، ونحنُ نقطنُ في قعرها، تلك الحُفرة السّحيقة التي نُدفعُ إليهَا دفعًا بالقوّة لا بالفِعل، بقوّة الآلة الطّبيعيّة العمياء التي تشتغل وفقًا لدوافع لا نُدركُها، لأنّها تقعُ خارج حُدود التمثّل الإنساني، كلّ ما ندركهُ أنّنا موجودون في قعر هذه الهاوية، منخرطون في طرق اشتغالها، تائهون في ثناياها، نخبطُ خبط العشواء في اللّيلة الظلماء ونُشاركُ في صناعة آلامنا وتأبيد معاناتنا، نُمنّي أنفسنا بغدٍ أفضل ونرفض الإقرار بأنّ بُؤسنا لن ينقضي إلّا بانقضاء نوعنا.
إنّ العالمَ مصنعٌ كبيرٌ لتكرير المعاناة وتأبيدها في عود أبديّ رتيب، تتغيّر الأزمنة وتتنوّع الأعراق وتتمايز الظّروف التّاريخيّة والثقافيّة، قد تتعدّد صيغ البؤس وتتفرّع معادلات الألم لكنَّ المعاناةَ واحدةٌ، إنّ هذا العالم ليس مكانًا للّراحة ولا للطُّمأنينةِ، إنّما هو ساحةٌ لخلق الحاجات والرّغبات التي لا تنتهي ولا تُشبع أبدًا، لا يكتفي الإنسانُ بالمُتاح ولا يشعر بالرّضا ولا يقرّ لمتطلّباته قرارٌ، بدءًا من أبسط احتياجاته وصولًا إلى أكثر رغباته ترفًا وفُحشًا، سيتألّمُ إنْ لم يُشبعها، وسيضجرُ سريعًا إذا قضى منها وَطَرًا، ليزداد من بعد ذلك تحرّقه إلى المزيد من مشتهيات نفسه ومآربها، لأنّ لحظة تحقيق الارتياح وملامسة اللّذّة تمرّ كلمح البرق . لقد أحسن شوبنهاور وصف هذا الوضع الوجوديّ حين قال:” تتأرجحُ الحياةُ كرقّاص السّاعة بين الألم والضجر. ”
يكُونُ العالم بمقتضى قانون الحاجات والرّغبات مسرحًا يخوض فيه الجميع الحرب ضدّ الجميع، حرب الأفراد على الأفراد والفرد على نفسه والنوع الاجتماعي على نظيره والأمم على الأمم والطوائف على الطّوائف والطبقات على الطبقات والنوع الإنساني على بقيّة الأنواع الحيّة، يتصارع الجميع من أجل سدّ حاجاتهم الجسديّة وإشباع رغباتهم المتجدّدة وانتزاع النّفوذ والهيمنة والمكانة والتفوّق وضمان ديمومة المصالح وتحقيق الأمن النفسي، إلى غير ذلك من متطلّبات النوع الإنساني التي تتجاوز منطق الحاجات الأساسيّة البسيطة، ذلك أنّ للإنسان رغبات بالغة التركيب ، مُشِطّة التعقيد ، يتعالق فيها العجيبُ والغريبُ واللّامُتوقّعُ، مثل أن يجلس سفّاحٌ إلى ضحيّته، يُقطّع أوصالها بدمٍ باردٍ، أو أن يُضحّي ملكٌ بجيش يُعدّ بالآلاف كي يحقّق رغبته في احتلال مدينة مجاورة أو أن يتلذّذ أحدهم بإلحاق الأذى بمن هم أضعف منه حالًا أو أن يستحمّ شخصٌ فاحش الثراء في حوض من الحليب والعسل كلّ يوم في حين يموتُ جارهُ جُوعًا وفقرًا…
ستطول القائمة إذا تمادينا في ذكر رغبات الإنسان الفاحشة، ذلك أنّ أنّها ليست من قبيل الشواذ من الأمور، بل هي مُحرّك التّاريخ الإنساني الرّئيس، ذلك التّاريخ الذي تحكمه الرّغبات والأهواء والأحلام والأمنيات الشخصيّة والمُصادفات والغباء وسوء التقدير، ذلك التاريخ الذي يُكتبُ في مقصورات الجواري وفي مجالس اللّهو والطرب وفي صالات القُمار وفي طموحات الزعماء الجامحة وفي هوامات المُجاهدين الجنسيّة وفي رُؤى الأنبياء الهاذية وفي مآرب أرباب الأموال الجشعة…
يُدركُ المالينخوليّ السّعيد أنّهُ عالقٌ في قعر هذا العالم/الهاويّة، ويعلمُ جيّدًا أن لا سبيل إلى تغييره أو إصلاحه، لذلك فهو لا يتّبع خطواته، بل يقبعُ آمنًا مُطمئنًّا في جحره الوجوديّ لا يغادره، يستيقظ كلّ يوم دون وجهة ولا هدف ولا غاية ولا سبب يدعوه إلى الانخراط في الحياة العامة، لقد قرّر الاكتفاء بتسطير الهجائيات، مهنته الوحيدة هي هجاء العالم وتعداد رذائله والتبرّؤ منه، وفي الأثناء يُصادِقُ الموت ويُغازلهُ، ويجدُ العزاء والسلوى في فكرة الفناء الأبديّ والعودة إلى ظلمات العدم، ف”لا مطلوب أبلغ من الموت” كما جاء على لسان ابن عربي.
إنّ هذا العالم سفينة سكرانة بلا ربّان، تتقاذفها أمواج الاحتياجات والرّغبات والأهواء والجُنون، وتُحاصرها شتّى العذابات والآلام، لا وجهة تنحو إليها ولا غاية تنشدُّ صوبها، لذلك فإنّ الانسحاب من الحياة العامة في هدوء لن يكلّفنا الكثير، بل إنّه المجد الوحيد الباقي، مجد الاستقالة من الوظائف الاجتماعيّة الباهتة، مجد الخروج من دوّامة الالتزامات التي لا تلزم، مجد الفرار من معركة نستبقُ خسارتها، مجد الحياة دون خوف ولا أمل ولا خيبات…
“نحنُ عبيدٌ ونبقى عبيدًا طالما لم نُشْفَ من عادة الأمل”… هكذا تحدّث الحكيم سيوران !
8 - الصّخرة الّتي لن يرثها أحدٌ من بعدي
“يومُ المماتِ خيرٌ من يومِ الولادةِ” – سفر الجامعة
“ألهاكُم التّكاثرُ حتّى زُرتُم المَقَابِرَ” – سورة التّكاثر
لا يُعادي المالينخولي السّعيد أمرًا مثلما يُعادي الإنجاب/التّكاثر/التّناسل البشريّ، ولا يخفي اشمئزازه من التّكاثريين ولا استحقاره لكلّ من يدعو إلى الرمي بالمزيد من الحطب/الأطفال في هذه المحرقة/الحياة. يمثّل الإنجاب في نظر صاحبنا الجريمة الأصليّة، أمّا بقيّة الجرائم على فظاعتها فلا تزيد عن كونها مجرّد تنويعات على ذلك الأصل. لقد أقرَّ إميل سيوران بأنّ الشيء الوحيد الذي يفتخر به هو أنّه اكتشف في سنّ مبكّرة جدًّا أنّه لا يتعيّن على المرء أن يُنجب، واعتبرَ الآباء كلّهم مجرمين وغير مسؤولين، بل ذهب إلى اعتبار أنّ لقب “والد” هو أبشع الألقاب وأكثرها وحشيّة.
انتهى ألبير كامو في مقاله “أسطورة سيزيف” إلى أنّ الحياة تستحقّ أن تُعاش على عبثيّتها وخلوّها من كلّ معنى، وإلى أنّه يجب علينا أن نتخيّل سيزيف سعيدًا على شقائه الرّتيب وبؤسه الأبديّ، وذلك -تقريبًا- ما يسعى إليه المالينخولي السّعيد محاولًا جعل تجربته الخاصة محتملةً، لكنّهُ لا يقبل أبدًا أنْ يُوَرِّثَ تلك الصخرة السيزيفيّة أحدًا، إنّ الحياةَ ميراثٌ ثقيلٌ وليس من الأناقة الوجوديّة أن نفرْضه على كائنات/مُصادفات منويّة أخرى.
تفتحُ الحياةُ فوهتها مثل بالوعة تستقبلنا ثمّ تُصرّفَنا في ثناياها، لنشرع في الرّكض واللّهاث، نُشبه قوارض المجاري في تيهها بحثًا عن نقطة ضوءٍ، لكنّنا في النّهاية لن نظفر بغير الموت. يُقذفُ بنا إلى هذه المتاهة كي نموت ببطئٍ وسط ضجيج الوعّاظ الّذين يُبشّروننا بأنّ كلّ شيءٍ يحدث لسببٍ مّا، وبأنّ حكمةً مّا تكمنُ خلف كلّ تفصيلٍ، كأنّ هذا الكون يُبالي بنَا أو يقيم لنا حسابًا. لقد خٌيّل إلينا في لحظة مّا أنّ وجودنا على سطح هذا الكوكب أهمّ من وجود حفنة من القراد والبراغيث على ظهر كلب، لقد بالغنا كثيرًا في تقدير أنفسنا، وأظنّ أنّ الوقت قد حان كي نُراجعَ سُوءَ تقديرنَا مُراجعةً جذريّة تكفي لأن نقرّر التوقّف عن إعادة إنتاج نوعنَا، وأن ننصرف عن هذا الكون بكلّ أناقة قبل أن نُلفظَ منهُ بالقوّة. لن يُشفى الإنسان من إنسانويّته/مركزيّته إلا حين يقوم باختراق وعيه الواهم بنفسه وينسفه كُليًا؛ حين نتساوى أنطولوجيًا بالبقّ والعثّ والبراغيث وحين ندرك أنّ خلوّ الكون من نوعنَا ليس مأساة كوسمولوجيّة، لن ترثينا النجوم ولن تبكينا الكواكب ولن تُعلن المجرّات الحداد علينا.
كلّنا جئنَا من الخطيئة، لا أقصد “الجنس” باعتباره شبقًا/متعةً خالصةً، بل أتحدّث عن مآل تلك المتعة حين تُصيّرُ مسخًا بشريًا جديدًا، نسخة أخرى من فساد الطّبيعة، توقيعًا آخر على سجلّ المعاناة. ما الخطيئة الأصليّة إن لم تكنْ خطيئة الإنجاب؟ لماذا نُصرُّ على تأبيد الشّقاء؟ ألمْ يُلعنْ آدم في سفر التكوين حتّى عُوقبَ بالكدح والتّعب في سبيل العيش حين قيل لهُ “ملعونةٌ الأرض بسببكَ؟ ألمْ يُحكمْ على حوّاء بوظيفة الإنجابِ حكْمًا يوضع في مقام العقاب لا الهديّة حين قيل لها “تكثيرًا أكثّر أتعابَ حبَلكِ، بالوجعِ تلدينَ أولادًا”؟ ألم يُخلقْ “في كبدٍ” وفق العبارة القرآنيّة؟ ألم يُوصف بأنّهُ ظلومٌ جهولٌ حين تحمّل ما لا طاقة له بتحمّله؟ … ثمّة حُدوسٌ كامنةٌ في السرديّة الإبراهيميّة تُنبئنا بأنّ الحياة نفسها غلطة وخطيئة تحمّلها الإنسان ولا يزال مصرًّا على تحمّلها حتّى تأتيه السّاعة بغتة…
إنّ ما هو كامنٌ عند الإبراهيميين الرسميين، يظهرُ بجلاءٍ في قصصيات الشرق الأقصى وفي تعاليم الغنوصيين، لقد اعتبر بوذَا أنّ جوهر الحياة معاناة، فالولادة في الأدبيات البوذيّة هي منبع الألم الأوّل ومصدر الشّرور جميعها. واتّفقت كثيرٌ من مدارس أهل الغنوص على أنّ هذا العالم لا يمكن أن يكون من فعل إله خيّرٍ، بل هو من صنع/اختلاق قوى شرّيرة، دعا النّبي البابلي ماني إلى تجنّب الإنجاب، معتبرًا ذلك خطوة كبرى نحو الخلاص النهائيّ، واعتبر الانكراتيون (جماعة مسيحيّة غنوصيّة) أنّ وسيلة البشر لقهر الموت هي التوقّف عن الإنجاب. فالتكاثر في نظرهم وسيلة تغذّي الموت بتكثير المواليد الميتين حتمًا.
تُحذّر التعاليم الأبيقوريّة من اللّذّة التي يعقُبها ألم، مثل لذّة الخمر التي قد يعقبها ألم الصداع والغثيان، ما فات أبيقور هو أنّ الجنس أيضًا لذّة قد يعقبها كائنٌ جديدٌ، قربانٌ حيٌّ مجبول من الانتشاء لكنّهُ مُكرّس للألم وللمعاناة، معاناة لا تدوم سويعات قليلة مثل صداع الكحول، بل تدوم حياةً كاملةً، ولا تُؤذي صاحبها فحسبُ، بل تمتدّ إلى الكائنِ الجديد الذي أفرزته تلك العمليّة المتعويّة.
كلّ متعة تُؤدّي إلى إعادة إنتاج الإنسان، لا يُعوّل عليها؛ تُعتبرُ متعة الجنس -من وجهة نظر تطوّريّة- مُكافأة تمنحها إيّانا الطّبيعة حتّى يُحبّب إلينا الإنجاب وبالتّالي نضمن بقاء النّوع واستمراره، لقد تفطّنَ آرثر شوبنهاور إلى هذا الفخّ الطّبيعي الّذي تقعُ فيه الأنواع الحيّة، وأقرّ بأنّ الطّبيعة تضحّي بالفرد في سبيل النّوع، إنّ كلّ ذلك يجري من خلال قوّة “الإرادة” العمياء الّتي تدفعنا إلى التشبّث بالحياة وإلى تمريرها إلى الأجيال اللّاحقة، لكن وحده النّوع الإنساني قادرٌ على أن يغنمَ متعة الجنس دون أن يُحقّق غرضَ حفظ النّوع من الانقراض، والميزة الوحيدة الّتي يحقّ للإنسان أن يعتدّ بها أمام بقيّة الأنواع هي ميزة الرّفض؛ رفض “الإرادة” وبرنامجها البيولوجي العبثي الّذي لا يفضي إلّا إلى المزيد من شقاء الأحياء.
-
*ياسين عاشور
*ياسين عاشور
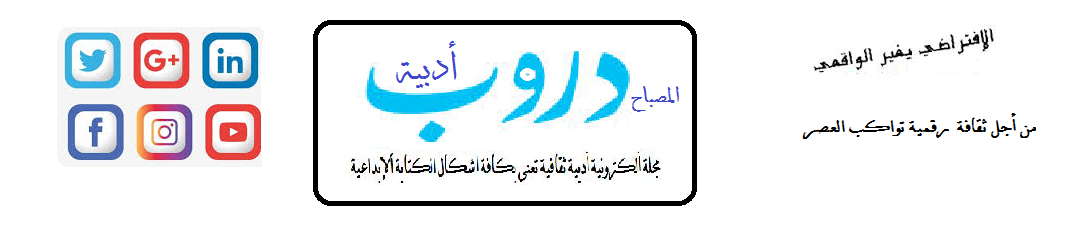


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق